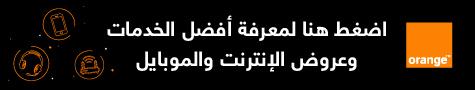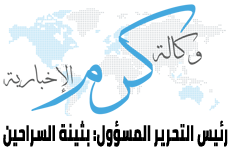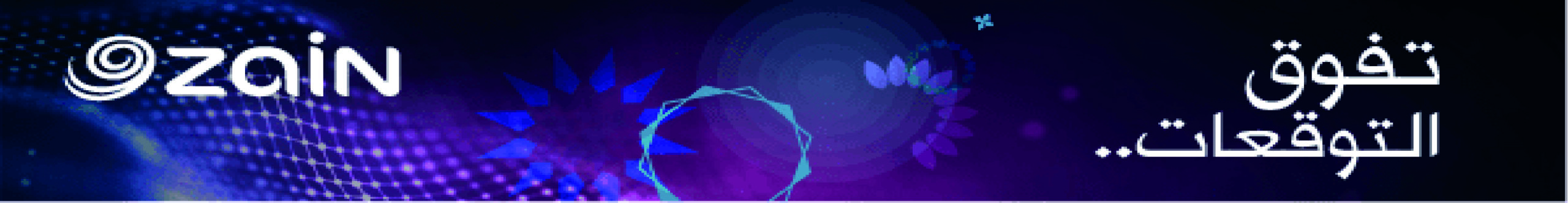السلطة الفلسطينية أمام سؤال المصير إسرائيل عالقة بين “وظيفة” السلطة و”دلالاتها”

الدكتور إياد البرغوثي*
لنعد إلى أوسلو (حيث نشأت السلطة)، كقاعدة انطلاق، لا لتسجيل موقف، بل للتذكير بكيفية النشأة وهدفها، ولاستقراء مصيرها، حيث المصير نتيجة النشأة، والنهاية أسيرة البداية، و”جينات” الأنظمة إذا ما دققنا في تاريخها مغطاة سلفاً، تحمل الصفات، وتشير إلى المصير.
يبرز الآن سؤال السلطة الفلسطينية أكثر من أي وقت مضى. وهو بالمناسبة سؤال إسرائيلي قديم ودائم، وسؤال فلسطيني حديث وظرفي. سؤال استراتيجي وسياسي وفي رأس جدول الأعمال إسرائيليا، وسياسي (شكلي) ومالي وفي باب ما يُستجد من أعمال (أو متفرقات) فلسطينيا.
من الواضح، أن هناك منعطفا حادا في موقف إسرائيل من السلطة، لكنه ليس تغييرا في الاتجاه، ولا تبديلا في وجهة النظر، بل منعطف صنعته طبيعة الطريق لا أكثر، وتطلبته الخطة “المرسومة”، وذهاب الفلسطينيين لتفسيره بصعود اليمين وتراجع اليسار، وتطرف الوزير واعتدال الرئيس في إسرائيل أو في أمريكا، ليس أكثر من تعبير “شعبوي” (طب شعبي)، فائدته الوحيدة تبديد الوقت في انتظار المصير المحتوم.
لنعد إلى سؤال النشأة، ما الذي أرادته إسرائيل من السلطة، وما الذي أراده الفلسطينيون منها؟. وكيف فهمها الإسرائيليون وكذلك الفلسطينيون وما علاقة ذلك بالسياسة والمعنى، والوظيفة والدلالة كوننا نبحث ذلك فلسطينزميا؟.
بالرجوع إلى أوسلو، ما الذي أرادته إسرائيل من السلطة في السياسة؟. إنه كما يرى معظم المهتمين، إنهاء الانتفاضة وتخفيف الضغط الأمني، والتخلص من عبء الإدارة اليومية للفلسطينيين بتحويل ذلك إلى سلطة محلية، وفتح باب التطبيع الإقليمي والدولي، وإدارة الصراع بدلا من حله. أما ما أراده الفلسطينيون (منظمة التحرير) فهو اعتراف دولي وتمثيل سياسي رسمي، وإنشاء سلطة “وطنية” على الأرض، وأفقٍ نحو دولة مستقلة.
في ذلك، وجد الإسرائيليون والفلسطينيون ممثلين بقياداتهم الرسمية، في السلطة الفلسطينية جسما (أداة) عملية لتحقيق التقاطعات (السياسية) بين أهداف كل منهما، ضمن مشروع “التسوية” المتفق عليه. لكن المشكلة نشأت من اختلاف الطرفين في رؤية المشهد وفهمه، حيث رآه الفلسطينيون سياسة فقط، في حين رآه الإسرائيليون سياسة ومعنى. الإسرائيليون اعتبروا أن المعنى ذروة السياسة بينما اعتبره الفلسطينيون بلا “معنى” في حضور السياسة.
منذ بداية العملية السياسية، كان الإسرائيليون ينجزون في السياسة وعيونهم على المعنى. كانوا يدركون أن السياسة لا تكون ناجزة من دونه، وأنه لا نصر حاسما ونهائيا بدونه. أما الفلسطينيون، فلم يعيروا المعنى الاهتمام الذي يستحقه، واعتبروا أن لا قيمة له إذا ما قورن بالسياسة، وأن استبداله بها “تجارة” هم فيها الرابحون.
فهم الإسرائيليون أوسلو ليس فقط كاتفاق سياسي، بل كنظام معنى أيضا. فالصراع عندهم ليس فقط على الأرض كما فهمه الفلسطينيون، بل على تعريف الواقع. لذلك كانوا يصرون بالإضافة إلى مطالبهم السياسية، إلى التدخل في المعنى وفي الذاكرة. منذ البدايات كان شرطهم إدانة الفلسطينيين للإرهاب، ليس فقط في ما سيكون، لكن أيضا في ما كان. وفي حين اعتبر الفلسطينيون ذلك أمرا شكليا لا “يستحق” التوقف عنده كثيرا، اعتبره الإسرائيليون أساسا ومقدمة لإجبار الفلسطينيين على تغيير ذاكرتهم وسرديتهم وحتى هويتهم.
كانت أوسلو بالنسبة للإسرائيليين ليست لحظة إنجاز سياسي فقط، بل أيضا تبدلا في المعنى إلى النقيض. فقبلها كان الإطار المعرفي لفلسطين يفترض أنها مسألة تحرر وطني، ومقاومة للإستعمار، ووحدة الشعب والأرض. أما بعدها فتحول المعنى من تحرر شامل إلى عملية تفاوض مستمرة (الحياة مفاوضات)، ومن حق تاريخي إلى تسوية (في أحسن حالاتها) سياسية، ومن وطن إلى أرض متنازع عليها. والمهم هنا أن السلطة الفلسطينية ظهرت داخل هذا التحول، وكأنها أداته، متبنية له، ومتصدية لمنتقديه.
حاول الفلسطينيون في أوسلو وبعدها تحقيق إنجازات سياسية، أو ذات طابع سياسي. من هذه الزاوية فهموا اعتراف إسرائيل بمنظمة التحرير كممثل لهم، ومنها أيضا فهموا عودة من عادوا من الفلسطينيين إلى الوطن بعد الاتفاق. وحرصوا على تفسير المحتوى “السيادي” للانتخابات وما انبثق عنها كالمجلس التشريعي والبلديات وغيرها. أما في الأماكن التي ظهرت كمنغصات “للسيادة” كما هو عليه الحال في تصرفات الإسرائيليين في المعابر والحدود والاستيطان وكل الأعمال الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين، فقد حرصوا على إيجاد “رمزية” سيادية، تتمثل في استحضار مظاهر للسيادة ورموزا للدولة، مثل الحكومة والوزراء والسفراء والأجهزة وغيرها.
كانت نتيجة “الاشتباك” السياسي الذي نشأ بعد أوسلو تراجعا كبيرا للسلطة كما هو معروف، فالدولة لم تتحقق وذلك بعد أن جعل الاتفاق فكرتها الأفق الوحيد المقبول دوليا، وشرط تحقيقه مقتصر فقط على التفاوض وموافقة الطرفين عليه. والاحتلال استمر، والإستيطان توسع، والسيادة لم تظهر، والسلطة لم تعد تمثل طريقا واضحا نحو الدولة، بل جزءا من إدارة بلا أفق، داخل نظام سيطرة أوسع.
تعاملت إسرائيل مع السلطة ليس كأداة سياسية ضمن مشروع تسوية، بل كإدارة مدنية للسكان، أداة إدارة لا شريكا سياسيا سياديا. لكن أزمة السلطة تلك، لم تقف عند كونها سياسية، بل تعدتها لتمس الشرعية والمعنى والتمثيل.
كان التآكل في البعد السياسي للسلطة فعلا إسرائيليا بالأساس، عززه وضع فلسطيني داخلي، اتسم بأداء فيه الكثير من المشاكل. لكن ذلك المآل السياسي للسلطة الذي أرادته إسرائيل، بعد أن حققت معظم أهدافها السياسية بوجود السلطة وبأيديها أحيانا، لم يحل دون انتقال إسرائيل إلى ما تريده من السلطة في جانب المعنى، حيث أرادت تغيير الوعي بالحق الفلسطيني وتحطيم كل ما يشير إليه ماديا ومعنويا. بذلك نفهم تدمير المخيمات، وضرب الاونروا، والهجوم على مؤسسات الشهداء والجرحى وكل ما يتعلق بالذاكرة الفلسطينية والسردية والمناهج والإعلام والمناسبات والأسماء، وكل ما يُذكر بفلسطين كقضية تحرر.
المفارقة هنا، أن السلطة المطلوبة إسرائيليا لإدارة الواقع “غير المريح”، وللمساعدة في تحقيق الإنجازات السياسية، والإجهاز على ما تبقى من معنى، مرفوضة عندما تقترب من السيادة، و”إشكالية” لأنها نفسها تحمل إسم فلسطين.
والإسم مسألة في غاية الأهمية خاصة عندما يتعلق الأمر بفلسطين. فهو يُذكر بالتاريخ وبالحق وبالهوية وبإمكان الدولة (في حال السلطة). إنه حضور لها في الوعي العالمي. ففلسطين لم تكن يوما مجرد جغرافيا. إنها حضور في المعنى والإسم له علاقة بإعادة إنتاج هذا الحضور. إنه فعل وجود ومقاومة، يثَبت الوجود ويحمي الذاكرة ويبقي الأفق مفتوحا. صحيح أنه ليس بديلا للتحرر، لكنه يمنع اكتمال المحو.
في السياق الفلسطيني، الإسم لا يعمل بوصفه علامة لغوية فقط، بل بوصفه إعلان وجود، وتثبيتا له في مواجهة محاولات الإلغاء، ومقاومة لاحتكار تعريف الواقع، وتصدٍ لتغييره.
لذلك، العقدة الإسرائيلية الأساسية (والنهائية) مع السلطة الفلسطينية إسمها. فإسرائيل التي تعمل منذ ما يقارب ثمانية عقود، على تغيير أسماء المدن والقرى والمواقع وكل ما يشير إلى فلسطين، تصطدم بحقيقة أنها تعمل ذلك بوجود سلطة يحمل إسمها فلسطين، ذلك الإسم الذي يعود بالحكاية إلى بداياتها.
هنا ينقسم الإسرائيليون، بين من يريد السلطة للإدارة وللإجهاز على ما تبقى من معنى، وبين من يرفضها ويدعو لإنهائها، لأنها هي نفسها آخر ما يتبقى من معنى. في هذا السياق على السلطة، إذا ما اعتقدت أن تخليها عن المعنى أمام الإسرائليين، ولو من باب “سحب الذرائع” كما يقال أحيانا، سيبقيها في منطقة “الراحة”، فإنها بذلك على العكس، ستجد نفسها أمام معركتها الأخيرة، وسؤال وجودها.
*أكاديمي وباحث فلسطيني