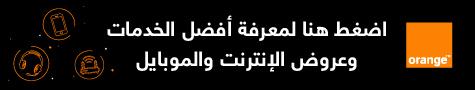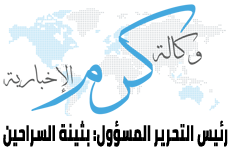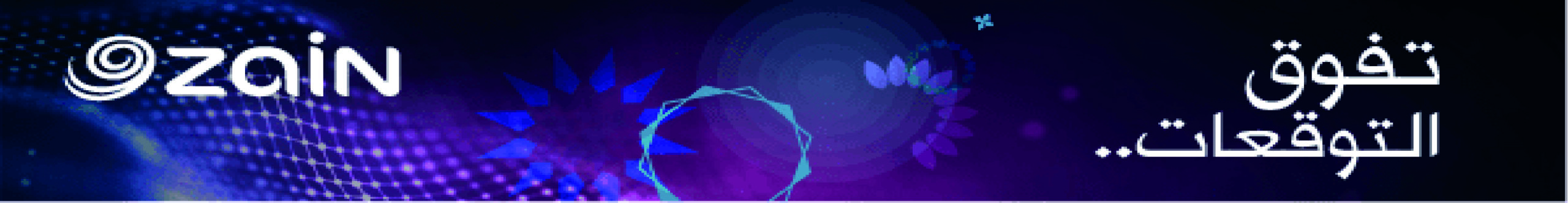السيادة الصناعية المفقودة: الصناعة الوطنية بين التبعية وفرصة النهوض
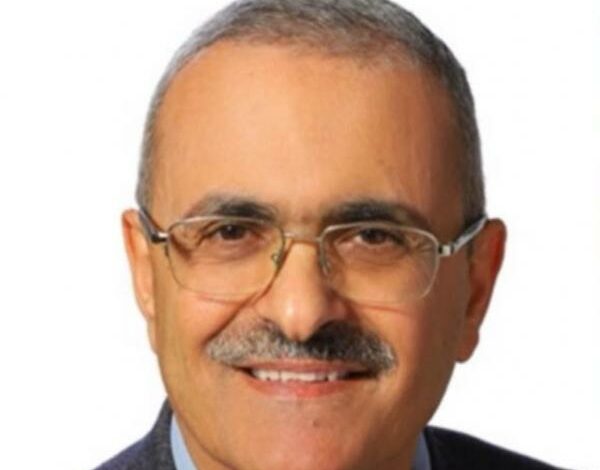
على مدى عقود، ظلّت الصناعة الوطنية في العالم العربي تُقدَّم بوصفها المحرّك الأساسي للنمو الاقتصادي، والمدخل إلى الاكتفاء الذاتي، ورافعة التحديث. غير أن هذا التصور، رغم وجاهته، أخفى وراءه منظومة عميقة من التبعية الاقتصادية والتكنولوجية، أنتجت مصانع تعمل بطاقة كاملة لكنها تُغذّي اقتصادًا مرهونًا بالخارج، وتستهلك تقنيات لا تتحكم فيها، وتنتج سلعًا تخضع في تصميمها ومعاييرها لمرجعية ليست محلية.
ما بدا نموذجًا للتنمية كان في كثير من الأحيان بابًا للاستلاب الصناعي. لقد تحولت كثير من قطاعاتنا الإنتاجية إلى مجرد خطوط تجميع لمنتجات مصممة في الخارج، أو مصانع لإنتاج مواد أولية تُصدر بأبخس الأثمان، لتعود إلينا في شكل سلع مصنعة بأسعار مضاعفة. وهكذا، صارت الصناعة الوطنية تدور في فلك المركز الصناعي العالمي، وتعمل وفق لغته ومعاييره، وتبقى رهينة لتقنياته وأسواقه، تمامًا كما يحدث في التعليم الذي يخضع لمعايير أكاديمية خارجية.
لم يعد خافيًا أن جزءًا كبيرًا من الصناعة العربية نشأ على نموذج استهلاكي لا إنتاجي. مصانع السيارات، على سبيل المثال، قد تنتج آلاف المركبات سنويًا، لكنها تعتمد في 80% من مكوناتها على استيراد خارجي. مصانع الإلكترونيات تُركّب شرائح وأجزاء مستوردة بالكامل، ومصانع النسيج تصدر خام القطن لتستورد القماش. هذه الدائرة المغلقة تُنتج اقتصادًا هشًا، وتُبقي الصناعة المحلية أسيرة الهامش في سلسلة القيمة العالمية.
هذه التبعية تتجلى أولًا في التكنولوجيا. فالآلة التي تنتج السلع ليست من صناعتنا، والمعايير التي نلتزم بها ليست من صياغتنا، وحتى براءات الاختراع التي نستخدمها مسجلة في مراكز أبحاث خارجية. التكنولوجيا هنا ليست أداة محايدة، بل منظومة قوة، ومن يتحكم في التقنية يتحكم في السوق وفي المنتج وفي حركة الاقتصاد. كما هو الحال في التعليم حيث اللغة تحدد نمط التفكير، في الصناعة التقنية تحدد نمط الإنتاج.
دراسات منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) أظهرت أن الدول التي لا تمتلك تقنيتها الإنتاجية تظل مقيدة في أسفل سلاسل القيمة، مهما زادت صادراتها. والأخطر أن الاعتماد على التكنولوجيا المستوردة لا يقتصر على المعدات، بل يمتد إلى البرمجيات وأنظمة التشغيل وإدارة الجودة، ما يجعل قرار الإنتاج نفسه مرتهنًا بموافقات وتراخيص وشروط خارجية.
يتعمق هذا الاغتراب الصناعي عندما ننظر إلى تصميم المنتج نفسه. فكثير من المصانع المحلية تنتج وفق تصاميم ومعايير السوق الخارجي، فتقيس نجاحها بمدى قدرتها على مطابقة متطلبات زبون أجنبي، لا بمدى تلبية حاجات المستهلك المحلي أو حل مشكلاته. وهكذا يصبح المصنع جزءًا من سلسلة إنتاج عالمية لا تملك التحكم في بدايتها ولا نهايتها، وتتحول الصناعة الوطنية إلى «مقاول من الباطن» في مشروع اقتصادي لا يحمل بصمتها.
هذه الوضعية لا تُخرجنا فقط من دائرة الابتكار، بل تجعلنا أسرى لتقلبات الأسواق العالمية والأزمات السياسية. فحين تُغلق الحدود أو تتعطل سلاسل الإمداد، تتوقف المصانع عن العمل لأن قطع الغيار أو المواد الخام أو المعرفة الفنية غير متوفرة محليًا. ولعل ما كشفته جائحة كوفيد-19 من هشاشة سلاسل التوريد العالمية كان إنذارًا واضحًا بأن الصناعة التي لا تمتلك سيادتها التقنية محكوم عليها بالانقطاع عند أول أزمة.
إن التفكير في نقلة نوعية للصناعة الوطنية لا يمكن أن يبدأ فقط بزيادة الإنتاج أو تحسين جودة المنتج، رغم أهميتهما، بل يجب أن يبدأ بإعادة طرح السؤال الجوهري: ما الصناعة التي نريد؟ ومن يحدد مواصفاتها؟ ولأي سوق ننتج؟ وهل هدفنا هو مجرد المنافسة على الأسعار في أسواق الآخرين، أم بناء قاعدة إنتاجية تخدم مشروعًا تنمويًا وطنيًا؟
التحرر الصناعي يبدأ حين نمتلك القدرة على تصميم ما ننتجه، وعلى إنتاج أدوات إنتاجنا نفسها. حين تكون خطوط التجميع من صنع أيدينا، وحين تكون برمجيات التحكم محمية محليًا، وحين تكون المعايير والمواصفات وليدة مراكز بحث وطنية، لا نسخًا من مواصفات أجنبية. يبدأ حين تصبح الصناعة جزءًا من مشروع سيادي، لا ملحقًا تجاريًا.
ما نحتاجه هو صناعة تفكر من بيئتها، وتبتكر من سياقها، وتستفيد من مواردها المحلية قبل أن تنظر إلى الخارج. صناعة تدمج البحث العلمي في قلب الإنتاج، وتربط المصانع بالجامعات، وتحوّل المراكز البحثية إلى خطوط إنتاج للمعرفة التقنية. صناعة لا تنحصر في تجميع الأجزاء، بل تتخصص في صناعتها، وتعمل على تطويرها، وتحمي ملكيتها الفكرية.
بهذا فقط نستعيد السيادة الصناعية، ونتحول من مستهلكين للتقنية إلى منتجين لها. وبهذا فقط نصنع اقتصادًا resilient قادرًا على الصمود في وجه الأزمات، والمنافسة بندّية، والابتكار من داخل بيئتنا. فالاستقلال الاقتصادي لا يبدأ من الأسواق، بل من المصنع. والسيادة لا تتحقق فقط في السياسة، بل تُصنع على خطوط الإنتاج، في ورش التصميم، وفي عقل المهندس الذي يعرف أنه لا ينتج سلعة فحسب، بل يبني استقلال أمة.
“الدستور”