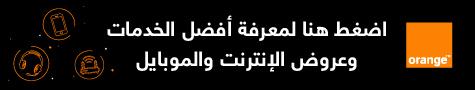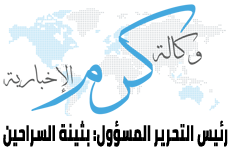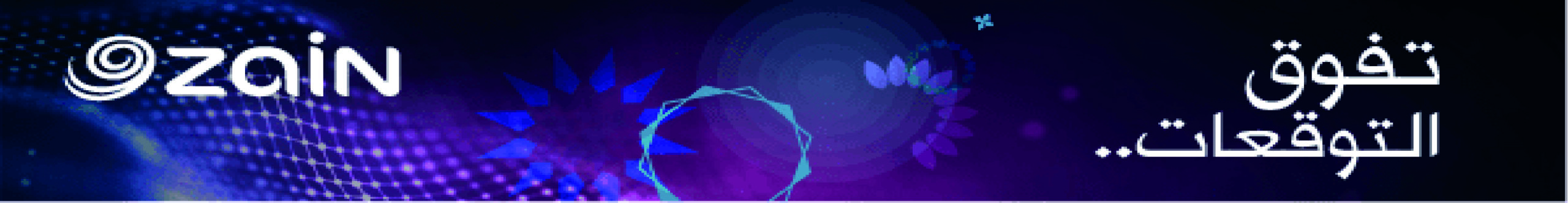زواج القاصرات
أتذكر إحدى زميلاتي في المدرسة. كنت في الصف الثاني اعدادي ( الثامن بتوصيفات اليوم )، وكانت تجلس على المقعد خلفي، وبسبب الملل الشديد الذي تعاني منه أثناء الدروس، كانت بين الوقت والآخر تنخزني لتسألني عن الوقت. لهذا قررت ذات يوم أن أشرح لها كيف تقرأ عقارب الساعة. خصصت لذلك وقت الاستراحة بين الحصص. في اليوم التالي وحينما نخزتني لتسألني عن الوقت، رفعت يدي لترى الساعة بنفسها. وأبقيت يدي مرفوعة ربما لدقيقة كي أضمن قراءتها للوقت. بعد الدقيقة سمعتها تقول: آآآآآه… وكانت هذه ال”آه” بمثابة دليل دامغ على أنها لم تستطع تحديد الساعة.
لم تكن هذه الطالبة جرّاء رسوبها في كل المواد، أو فشلها في تعلّم قراءة عقارب الساعة، تعاني الحرج أو أي من العقد، فقد كانت تستمد ثقتها العالية بنفسها من بياض بشرتها ومن جمال ساقيها. كانت بيضاء، وقصيرة ومتلئة الجسد . تسارع ما أن تطلب منا مربية الصف أن نشطفه أثناء حصة الفن، للتشمير عن ساقيها واستعراض جمالهما، ثم سرعان ما تنجح في تحويل الشطف إلى مناكفات بينها وبين البقية حول من تملك أجمل سيقان. أجل كانت غالبية بنات الصف يغرن منها ومن بياض ساقيها، الأمر الذي يعني بنظرهن أن فرصتها للخطوبة عالية وتفوق فرصهن. وهذا ما حدث، فقد جاءت ذات يوم تحمل علبة حلوى ووزعتها علينا وهي تزف خبر خطوبتها. حينها رمقتها كثيرات بنظرات الحسد، متنهدات: متى أيضا سيحدث لهن ذلك ويأتين بخاتم خطبة في أصابعهن، وعلبة حلوى لا يخفينها في حقيبة المدرسة، لأن المدرسة مع هذه العلبة ستفقد هيبتها واهميتها.
في ذلك العام، وحتى نهاية المدرسة، كان عدد الطالبات في الصف يتناقص شيئا فشيئا، فبين الوقت والآخر كانت تأتي إحداهن تحمل علبة حلوى توزعها علينا بزهو، ثم تجلس ساهمة طوال الحصص تفكر بفستان العرس.
تذكرت هذه المشاهد بعد سنين حينما عدت إلى مدينتي التي غبت عنها طويلا. كنت أجلس أمام أم عريس أنظر إلى وجهها وهي تجيبني بسعادة على سؤالي عن عمر العروس التي خطبوها لابنهم: “صغيرة! لم تكمل المدرسة بعد، وما شاء الله عنها: بيضاء وجميلة”. لحظتها لم تخطر ببالي أفكار تخص حقوق الطفولة، أو حقوق المرأة، ولم أتخيل صخب النسويات المدافعات عن حرية المرأة. لم يخطر ببالي أن العروس ـ الطفلة ـ قد سجنت نفسها في غرفتها واضربت عن الطعام احتجاجا على تزويجها المبكر. ما خطر ببالي مشهد وحيد: مشهد زميلتي وهي مشمرة عن ساقيها المكتنزتين، متباهية بياضهما، وبعدد الخطاب الذين يطرقون باب بيت أبيها.
في الحقيقة لم يخطر ببالي أيضا أن زميلتي تلك كانت طفلة، وكان يجب الدفاع عن حقوقها. فكرت بأنها كانت تعي على نحو فطري وغريزي، بفعل ثورة الهرمونات في جسدها، دورها في الحياة: الزواج والتكاثر، وكانت ملهوفة لأن تؤديه. لهذا لم يعنها في يوم من الأيام أن تفهم المعادلات الرياضية أو أن تفهم قانون الجاذبية. هذا الإدراك الغريزي للحياة، هو نتاج طبيعي لبيئة ولمجتمع لا يدرك أهمية المعرفة ولا أهمية العلم أو العقل. في الجوهر هو يربي أفراده حسب متطلبات الغرائز، فيغدو فيه بياض البشرة هو كل ما يعوز “الأنثى” لتشعر بالتميز ولتصبح مطلوبة، كأي سلعة أخرى. مطلوبة لا لرجل، بل لذكر.
هذا الأمر مؤسف للغاية، لكن الكارثة لا تكمن هنا. الكارثة الحقيقية تكمن في السلطة حينما لا تتناقض في رؤاها مع معايير هذا المجتمع وقيمه، بل تصبح انعكاسا أصيلا ومعبرا دقيقا عنه. تتفق معه وتسن معاييره في قوانين: تبيح زواج القاصرات والقاصرين، مكرسّة بذلك غرائزيته وحيوانيته…نائية بأميال وأميال عن الإنسان والإنسانية، ونائية بالتالي عن الحضارة، فمن يصنع الحضارة هما امرأة ورجل، وليس ذكر وأنثى.