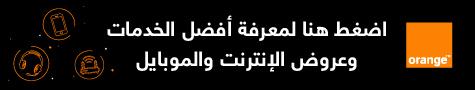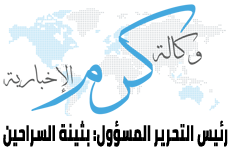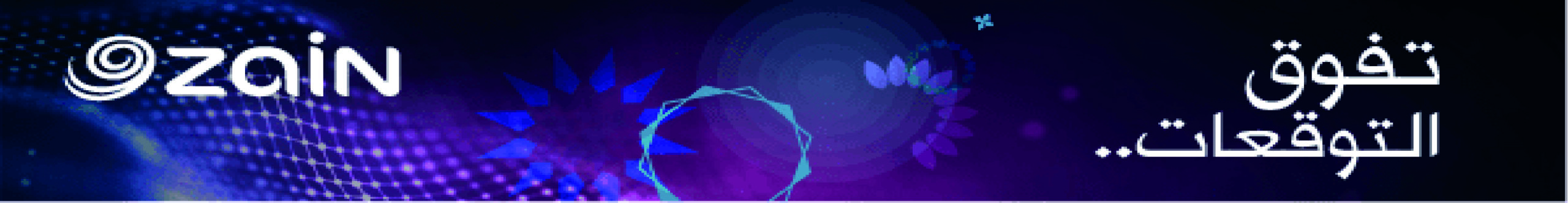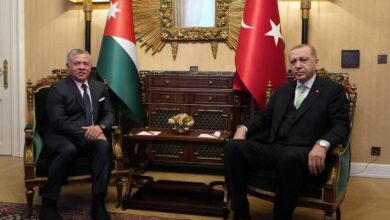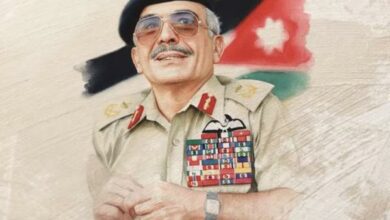كتاب وقارئ 4 .. المدينة العتيقة

إبراهيم غرايبة
المدينة العتيقة. تأليف فوستيل دي كولانج. ترجمة عباس بيومي.
يعتبر كتاب المدينة العتيقة لمؤلفه الفيلسوف الفرنسي فوستيل دي كولانج (1830 – 1889) من الكتب الكلاسيكية في تاريخ الدين والمدينة، ويندر ألا يستشهد به باحث يكتب في هذا المجال. كان كولانج أستاذ ورئيس قسم التاريخ في جامعة سوربون، وينسب إليه تأسيس المنهج العلمي في دراسة التاريخ في فرنسا.
يقدم الكتاب إضاءات بالغة الأهمية في تاريخ الدين والأفكار وملاحظة العلاقة بين تشكل الأمم حول مواردها وأفكارها. يذكر كولانج بأن الأسرة نشأت قبل المدينة، وفي ذلك كان القانون الخاص بها مختلفا عن المدينة، فليس من مصلحة المدينة أن تكون الأرض غير قابلة للتنازل، والميراث غير قابل للقسمة. وكان القانون يسمح للأب ببيع ابنه أو قتله. لكن المدينة ترى أن حياة زوجتك وطفلك وحريتهما ليستا ملكا لك، وأن المدينة تحميهما حتى منك أنت. فلست أنت الذي تحاكمهما. ولكن المدينة أخذت القانون كما كان موجودا قبلها، ولم تغيره إلا عبر زمن طويل، فقد كان هذا الشرع قائما من قبل، وممتدا في العقائد الدينية والعادات والثقافة العامة.
تقول القوانين الإغريقية: “تخضع المرأة لأبيها وهي بنت، فإذا مات الأب خضعت لإخوتها ولعصبتها. وتكون وهي متزوجة تحت وصابة زوجها، فإذا مات زوجها لا تعود إلى أسرتها الأصلية، إذا أنها بزواجها تكون قد تنازلت عنها إلى الأبد، .. ويظل الأبناء قاصرين مهما بلغوا من العمر مادام أبوهم حيا” وبالطبع فإنها قواعد مستمدة من الديانة المنزلية، وقد بدأ تأثيرها يضعف مع التطور الديني والحضاري.
كان الأب يتمتع بالرئاسة الدينية، وحق الاعتراف بالطفل عند مولده أو إنكاره، وحق طلاق الزوجة، وتعيين وصي على الزوجة والأولاد عند وفاته، ويوجد في الشرع الروماني والأثيني ما يسمح للأب ببيع أبنائه. وكان للأب حق الحكم بالإعدام على الزوجة والأبناء والبنات،..
ثم تطورت الفكرة الدينية وكبرت مع نمو الجماعة البشرية، وفي واقع لحال فإنهما (الفكرة الدينية والجماعة البشرية) يكبران في وقت واحد. كان القدماء يعتقدون أن كل غذاء يجهز على مذبح ويقتسمه عدة أشخاص يقيم فيما بينهم رابطة لا انفصال لها واتحادا مقدسا لا ينقطع إلا بالموت.
يمثل الأسلاف بأرواحهم وذكرياتهم منشأ عقائد الأمم وافكارها وقيمها، وكان الموقد هو الرمز الأساسي لرسالة الأسلاف ووجودهم، وهكذا تكونت الأسرة، والقوانين الأولى أيضا، ويمكن الملاحظة أيضا كيف أن الآلهة كانت تتخذ رمزها من النفس البشرية ومن الطبيعة المادية، وإذ كان الإحساس بالقوة الحية وبالشعور الذي يحمله الإنسان في نفسه قد ألهمه الفكرة الأولى عن الإلهيات فإن رؤية هذه اللانهاية التي تحيط به وتسحقه قد رسمت لشعوره الديني مسلكا آخر. كان الإنسان في العصور الأولى في مواجهة الطبيعة بلا انقطاع.
ولما تكن عادات الحياة المتحضرة قد ضربت بينهما ستارا حاجزا، فكان ذلك الجمال يسحر بصره وتلك العظمة تبهره، كان يستمتع بالضوء ويفزع من الليل وعندما يرى “عودة ضياء السموات المقدس” كان يشعر بالعرفان الجميل.
لقد لكانت حياته تبدو في يد الطبيعة، فكان ينتظر السحاب المحسن الذي يتوقف عليه محصوله، ويخشى العاصفة التي تستطيع أن تحبط عمله وأمل عام بأكمله، كان يشعر في كل لحظة بضعفه وبقوة ما يحيط به قوة لا نظير لها، كان يحس على الدوام بمزيج من التبجيل والمحبة والفزع نحو هذه الطبيعة الجبارة. لم ينته به هذا الشعور فورا إلى إدراك إله واحد يدبر الكون، إذ لم تكن لديه عندئذ فكرة الكون.
لم يكن يعلم أن الأرض والشمس والكواكب أجزاء من مجموع واحد. ولم ترد على ذهنه فكرة أنه يمكن أن يهيمن عليها كائن واحد.
عندما انتقلت الآلهة من مجال الأسر إلى المدينة، كان يجري اختيار آلهة إحدى الأسر لتكون آلهة المدينة، وتصير كهانة هيكل الآلهة في هذه العائلة. ويمكن الاعتقاد بأن العناصر الأولى لديانة الطبيعة هذه عتيقة جدا، وربما كانت تضاهي عبادة الأسلاف في القدم. ولكن بما أنها كانت تقابل أفكارا أعم وأسمى من هذه فقد كان لا بد لها أن من وقت أطول لكي تثبت في صورة مذهب واضح. ومن المحقق أنها لم توجد في العالم في يوم واحد وأنها لم تخرج تامة الخلق من عقل رجل واحد، بل ولدت في العقول المختلفة بأثر من قوتها الطبيعية فتصورتها كل عقلية على طريقتها، وقد كانت هناك أوجه شبه بين جميع هذه الآلهة التي خرجت من أذهان مختلفة لأن الأفكار كانت تتكون في الإنسان على طريقة تجري على وتيرة واحدة تقريبا.
والواقع أن كل فرد لم يكن يعبد إلا عددا محدودا من المعبودات، لكن آلهة الواحد لم يكن يبدو عليها أنه آلهة الآخر، وفي الحق أنه كان في الإمكان أن تتشابه الأسماء، فمن الجائز أن كثيرا من الناس قد أطلقوا على آلهتهم اسم أبولون أو هيراكليس؛ إذا أن هذه الألفاظ كانت تنتمي إلى لغة الاستعمال اليومي، ولم تكن غير نعوت تدل على الذات الإلهية بصفة أو بأخرى من أكثر صفاتها بروزا. لكنه لم يكن في استطاعة المجموعات المختلفة من البشر أن تعتقد أن هذا الاسم ذاته لم يكن ينطوي إلا على إله واحد، فكانوا يعدون إذن آلافا مختلفة من الإله جوبيتر، وكانت هناك جمهرة من الإلهات مثل منيرفا وديان وجونون قل أن تتشابه فيما بينها، وحيث أن كل واحدة من هذه التصورات قد كونها الجهد الحر الذي بذلته كل عقلية على حدة، وكانت إلى حد ما ملكا لها، فقد حدث أن بقيت هذه الآلهة مستقلة عن بعضها زمنا طويلا، وإن كان لكل واحد منها أسطورته الخاصة وعبادته.
من هنا أتت آلاف العبادات المحلية التي لم تستطع الوحدانية أن تستقر بينها، ومن هنا هذه المناضلات بين الآلهة التي تملأ عهد تعدد الآلهة والتي تمثل منازعات الأسر والنواحي والمدن، ومن هنا هذا الجمهور الذي لا حصر له من الآلهة والذي لا نعرف عنه عير الجزء الأصغر، إذ ان كثيرا منها قد هلك دون أن يترك حتى اسمه، لأن الأسر التي كانت تعبدها قد انقرضت أو أن المدن التي خصتها بعبادة قد دمرت. وعندما نرى هذه المعابد تقام وتفتح أبوابها لجمهور العابدين يمكن أن نطمئن إلى أن الإدراك البشري وإلى أن المجتمع قد اتسعا منذ زمن بعيد.
الدين في حالته الأصلية هو الإيمان بالله والعمل الصالح، “إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا” (فصلت، 30) لكن في تفاعله مع حياة الناس وأعمالهم وفي التحولات الاقتصادية والاجتماعية للأمم على مدى القرون ينشأ فكر ديني يستجيب لهذه التحولات، وقد كانت الأسرة ثورة اجتماعية وحضارية في تاريخ الإنسانية ومسارها، وصارت بطبيعة الحال حجر الأساس في التنظيم الاجتماعي وفي التزام الأفراد تجاه بعضهم، ثم نشأت القوانين والتشريعات الأسرية التي مازالت في امتداداتها وتفاعلاتها تحمل بصمة النشأة والرواية المؤسسة، وقد يفسر ذلك ما يبدو اليوم تناقضا أو صراعا في القيم والقوانين والأفكار، مثل “تأديب الأولاد والزوجة” إذ أنه عندما كان العالم أسرا وليس مدنا وممالك كما نعرفه اليوم، كانت الأسرة تؤدي في التنظيم الاجتماعي والاقتصادي ما تؤديه اليوم المدن والدول.
يقول المؤرخ الروماني تيتوس ليفيوس (59 ق.م – 17م) عن روما ليس في هذه البلدة مكان لم يتشبع بالدين ولا يشغله معبود ما؛ الآلهة يسكنونها. ويقول فوستيل دي كولانج: هناك حقيقتان مهمتان في تأمل الشعوب؛ الأولى إن المدينة كانت حلفا من مجموعات تكونت قبلها، والأخرى إن المجتمع لم يتطور إلا متدرجا مع اتساع المدينة، وليس في الاستطاعة البت فيما إذا كان التقدم الديني هو الذي جلب التقدم الاجتماعي، إنما المحقق هو أن الإثنين قد حدثا في وقت واحد وفي اتفاق عجيب. وإذا تأملنا جيش المدينة في العصور الأولى وجدنا أنه كان موزعا على قبائل وندوات وأسر “بحيث يكون جار المحارب في القتال هو ذات الشخص الذي يريق معه السوائل في زمن السلم ويقدم القرابين على نفس المذبح”
لم يكن لفظا مدينة وبلدة مترادفين عند القدماء، فالمدينة كانت تجمعا دينيا وسياسيا بين الأسر والقبائل. وكانت البلدة مكان الاجتماع ومقر الجماعة وخاصة مكانها المقدس. وتصلح روما كما يقول كولانج مثالا لقصة المدينة بالرغم مما هو مألوف من عدم تصديق هذا التاريخ القديم. كثيرا ما يردد أن رومولوس كان رئيسا لعصابة من المغامرين وأنه كون لنفسه شعبا باستدعائه الصعاليك والخارجين من المجتمع والخارجين عليه، وأن جميع هؤلاء الناس الذين جمعهم من غير اختبار بنوا مصادفة بضعة أكواخ ليحفظوا فيها غنائمهم. لكن رأينا في تاريخ روما وتأسيسها الديانة التي تنظم حياة الناس الخاصة وكل أعمالهم، وهذه الديانة نظمتهم في مجتمع، فأي عجب بعد هذا في أن يكون تأسيس بلدة ما عملا مقدسا كذلك، وأن يقوم رومولوس نفسه بهذه الشعائر التي كانت تراعى في كل مكان؟
كثيرا ما كان يحدث أن تستقر جالية أو غزاة في بلدة مبنية من قبل، فلم يكن عليهم أن يبنوا بيوتا إذ ما من شيء يحول دون سكناهم بيوت المغلوبين، لكن كان عليهم أن يقوموا باحتفال التأسيس أي يضعوا موقدهم هم وأن يثبتوا آلهتهم القوميين في مقرهم الجديد، ولهذا نقرأ في ثوقيديديس وفي هيرودوت أن الدوريين أسسوا اسبرطه واليونانيين مليتوس مع أن هذين الشعبين وجدا هاتين البلدتين كاملتي البناء وقديمتين جدا في ذلك الحين.
ما قاله تيتوس ليفيوس عن روما “ليس في هذه البلدة مكان لم يتشبع بالدين ولايشغله معبود ما. الآلهة يسكنونها” يستطيع كل إنسان أن يقوله عن كل بلدة أو مدينة، لأنها إذا كانت قد أسست طبقا للشعائر فإنها تكون قد تلقت بداخل سورها آلهة حماة كما لو كانوا قد غرسوا في أرضها ولن يفارقوها أبدا. كل بلدة كانت مقدسة. المؤسس هو الرجل الذي يقوم بالعملية الدينية التي بدونها لا يمكن أن توجد البلدة، فهو الذي يضع الموقد الذي توقد فيه النار المقدسة إلى الأبد، وهو الذي يدعو الآلهة بدعواته وشعائره ويثبتها في البلدة الجديدة إلى الأبد. وما من شيء كان علقا بقلب المدينة بقدر ما كانت ذكرى تأسيسها، عند ما زار بوسانياس بلاد الإغريق في القرن الثاني من الميلاد المسيحي استطاعت كل بلدة أن تحدثه عن اسم مؤسسها ونسبه وأهم الاحداث في حياته، ولم يكن من المستطاع أن يخرج هذا الاسم وهذه الأحداث من الذاكرة؛ إذ أنها كانت جزءا من الدين، وكانت تستعاد ذكراها في الاحتفالات المقدسة كل عام.
كان لكل مدينة آلهة لا ينتمون إلا لها. وفي العادة كانت هذه الآلهة تنتمي إلى آلهة وديانات الأسر الأولى. لقد كان الإنسان يعبد أولا القوة الخفية الخالدة التي يحس بها في نفسه، هؤلاء الكائنات العظيمة والخفية والأبطال هم في أغلب الأحوال أسلاف الشعب. كان يدفن الجسد إما في البلدة نفسها وإما في الأرض المحيطة بها. وكان يصبح إلها للمدينة كل رجل أدى لها خدمة جليلة، من مؤسسها إلى من أحرز لها نصرا أو أدخل تحسينا على قوانينها، أو أثر على معاصريه تأثيرا قويا. وكان لكل مدينة هيئة كهنتها التي لا تتبع أية سلطة أجنبية، فلم تكن هناك رابطة بين كهنة مدينتين ولا صلة ولا تبادل في التعليم أو الشعائر.
كان الطعام يبدأ بالدعاء وإراقة السوائل، وإنشاد الأناشيد، وكان كتاب الشعائر في كل مدينة ينص على الأطعمة والخمور التي يجب تقديمها، وكان الخروج في أي شيء عن العادة التي اتبعها الأسلاف يعد كفرا خطيرا تؤاخذ به المدينة أمام الآلهة، بل كانت الديانة تذهب إلى حد تعيين طبيعة الأواني التي يجب استعمالها سواء لطهي الأطعمة أو لخدمة المائدة.
في ملحمة إنييد لم يستقبل لاتينوس الشيخ رسل إينياس في مسكنه، بل في معبد قدسته ديانة الأسلاف، فهناك كانت تقام الولائم المقدسة بعد تقديم الأضاحي، وهناك كان يجلس كل رؤساء الأسر معا إلى موائد طويلة، وفيما بعد عندما وصل إينياس عند إيفاندروس وجده يحتفل بقربان الملك في وسط شعبه، والجميع متوجون بالزهور، وكلهم جلوس إلى نفس المائدة، يتغنون بنشيد في مدح إله المدينة.
وفي كل زمان وفي كل مجتمع أراد الإنسان أن يكرم آلهته بالأعياد، فقرر أن تكون هناك أيام لا تسود روحه فيها غير العاطفة الدينية، دون أن تشغل باله الأفكار والأعمال الدنيوية، فجعل للآلهة نصيبا في تلك الأيام التي قدر له أن يحياها. وتأسست كل مدينة بمقتضى شعائر كان أثرها في رأي القدماء أنها تثبت الآلهة القوميين في نطاقها. وكان لا بد من تجديد فضائل هذه الشعائر كل عام باحتفال ديني جديد، وكانوا يسمون هذا العيد يوم المولد، وعلى جميع المواطنين أن يحتفلوا به. كان كل ما هو مقدس مصدرا لعيد، فكان هناك عيد لسور المدينة، وعيد لحدود المنطقة، وفي تلك الأيام كان المواطنون يؤلفون موكبا كبيرا مرتدين الأردية البيضاء، ومتوجين بأوراق الشجر، ويطوفون حول البلدة أو المنطقة وهم يتلون الأدعية، وفي المقدمة يسير الكهنة يقودون الأضحية التي كانت يضحى بها في نهاية الاحتفال. وكانت هناك أيضا أعياد الحقول، وعيد الحرث وعيد البذر وعيد الازدهار وعيد قطف العنب، وكان كل عمل في حياة الزارع في بلاد الإغريق وإيطاليا ينظم بأعياد يشرب فيها الخمر الجديد، كانت الديانة تنظم كل شيء، والديانة هي التي تأمر بتشذيب الكروم لأنها كانت تقول للناس: إنها لخطيئة أن تريقوا للآلهة خمر كرمة لم تشذب. وكان لهذه الأعياد يوم محدد في السنة، يحرم فيه العمل، ويفرض الفرح والمرح والجهر بالغناء والألعاب، وتضيف الديانة: حاذروا أن يؤذي بعضكم بعضا.
يعتقد المؤلف فوستيل دي كولانج أن الدين أنشأ الدولة والمواطنة، وكانت تبعية الدين للدولة مرحلة متأخرة في مسار البشرية، وكان فقدان حق المواطنة هو عقاب الرجل الذي لم يساهم في العمل الديني، إذ لا يعود في مقدوره أن يكون عضوا في المدينة. ولذلك لم يعرف الرومان ولا الإغريق نزاعا بين الدولة والمؤسسة الدينية، والسبب كما يقول كولانج هو أن الدولة في روما وإسبارطا وأثينا كانت مرجعيتها الديانة.
كانت النصوص الدينية سرا لا يجوز الاطلاع عليه الا لفئة محددة، ولا يجوز إفشاؤها إلى أحد وخاصة الأجانب. وحيث أن السلطة في الأسرة ملازمة للكهنوت وأن الوالد باعتباره رئيسا للعبادة المنزلية كان في نفس الوقت قاضيا وسيدا، كذلك كان كاهن المدينة الأكبر هو أيضا الرئيس السياسي، فالمذبح هو الذي يمنحه الوظيفة، حسب تعبير أرسطو، وليس في هذا الخلط بين الكهنوت والسلطان ما يثير العجب، إذ هو موجود في أصل كل المجتمعات؛ إما لأنه في ابتداء تكون الشعب لم يكن يستطيع الحصول على الطاعة سوى الديانة؛ وإما لأن الطبيعة الإنسانية تحس بحاجتها لعدم الخضوع إلا لسلطة الخالق. يقول أرسطو: لملوك إسبارطا ثلاثة اختصاصات: تقديم القرابين، والقضاء، وقيادة الحرب.
كان القانون عند الإغريق وعند الرومان وكذلك عند الهنود في أول الأمر جزءا من الديانة، وكانت مجموعة قوانين المدينة هي مجموعة من الشعائر والفرائض الدينية والأدعية والنصوص الشرعية في آن واحد، وكانت قواعد حق الملكية وحق الإرث متفرقة بين القواعد الخاصة بالقرابين وبالدفن وبعبادة الموتى. ندرك من ذلك احترام القوانين والتمسك بها، وهو ما حافظ عليه القدماء زمنا طويلا. لم يروا في القوانين عملا بشريا، فقد كان لها أصل مقدس، لم يكن من اللغو أن يقول أفلاطون إن طاعة القوانين هي طاعة الآلهة. حيث أن القانون كان جزءا من الديانة فقد كان له نصيبه من صفة السرية التي كانت لجميع ديانة المدن، فكانت صيغ القانون سرا مكتوما كصيغ العبادة، كانت مخبأة عن الأجنبي بل مخبأة عن العامة والحلفاء، ولم يكن ذلك لأن البطارقة حسبوا أنهم يستمدون قوة كبيرة من احتكار تملك القوانين بل لأن القانون بحكم أصله وطبيعته، قد لاح لهم زمنا طويلا سرا لا يمكن أن يتلقنه الإنسان إلا بعد أن يكون قد تلقن أولا العبادة القومية والعبادة المنزلية.
كان المواطن يعرف أن له نصيبا في عبادة المدينة، ومن هذه المساهمة كان يستمد كل حقوقه المدنية والسياسية، فإن تنازل عن العبادة فقد تنازل عن الحقوق، وكانت الولائم العامة أهم احتفال للعبادة القومية، وفي اسبارطا كان من يتخلف عن الحضور يحرم من حسبانه بين المواطنين. كانت كل مدينة تفرض أن يشترك كل أعضائها في أعيادها وشعائرها الدينية.
ولكي يستطيع الأجنبي المتاجرة والتعاقد والحصول على الأمان يجب أن يكون مولى لمواطن. كانت روما وأثينا تطلب من كل أجنبي أن يتخذ وليا. وحينها يكون في مقدروه الحصول على الحماية المدنية. وكانت الجمهوريات القديمة تكاد تسمح للمذنب أن يفر من الموت بالهروب من الوطن، فالنفي لم يكن يبدو أخف وطأة من الموت، لقد كان الفقهاء الرومان يعتبرونه عقابا بالإعدام.
كان للمنتصر أن يستغل انتصاره كما يشاء، فما من قانون إلهي أو بشري يوقف انتقامه أو جشعه، واليوم الذي قررت فيه أثينا أن يباد جميع الميتيلينيين لم تكن تعتقد أنها تعدت حقها. وعندما رجعت عن قرارها في اليوم التالي، واكتفت بإعدام ألف مواطن ومصادرة جميع الأراضي اعتقدت في نفسها الإنسانية والرحمة، وبعد الاستيلاء على بالاتيا ذبح الرجال وبيع النساء، ولم يتهم أحد الغالبين بأنهم اعتدوا على الحق.
وبالقضاء على ديانة المدينة تختفي في نفس الوقت ديانة كل أسرة، وتنطفئ المواقد، ومع العبادة تسقط القوانين والشرع المدني والأسرة والملكية وكل ما يستند إلى الديانة، ويعلن المغلوب الذي أنعم عليه بالحياة “إني أعطي شخصي وبلدتي وأرضي والماء الذي يجري فيها وآلهة تخومي ومعابدي ومنقولاتي وكل الأشياء التي للآلهة للمنتصرين.
كان من المعتاد أن تحدد قوانين كل مدينة الملابس، فكان تشريع إسبارطا ينظم لباس الرأس للنساء، وتشريع أثينا يحرم عليهن أن يحملن في السفر اكثر من ثلاثة ثياب، وكان القانون في رودس يحرم حلق اللحية، وبالعكس كان يحتم في إسبارطا حلاقة الشارب.
لم يكن أصلب من الأسرة في العصور القديمة، وكانت تتضمن في ذاتها آلهتها وعبادتها وكاهنها وحاكمها، وكذلك الأمر بالنسبة للمدينة، والتي كانت تتحكم بروح الإنسان وبدنه.
لقد انحسر هذا النظام الاجتماعي الديني، بسبب التطور الطبيعي في العقلية الإنسانية، والذي محى العقائد العتيقة، فانهارت معها البيئة الاجتماعية التي أقامتها هذه العقائد، ووجود طبقة من الناس كانت موضوعة خارج نظام المدينة، وكانت تتألم من ذلك، ومن مصلحتها أن تدمره، فحاربته حربا لا هوادة فيها. وعندما ضعفت العقائد التي تأسس عليها النظام الاجتماعي، وأصبحت مصالح سواد الناس مناوئة لهذا النظام كان من المحتم أن يسقط، وما من مدينة نجت من قانون التغيير.
لكن العقائد والآثار لا تختفي نهائيا، وإنما تتحور وتتحول، وتظل بقاياها وامتداداتها عبر العصور، ويمكن أن نلاحظ اليوم في حياتنا الدينية والتشريعية حضور الأسرة والمدينة، ودورهما في تحديد المواطنة والحقوق والواجبات، وفي التشريعات والتنظيم الاجتماعي والسياسي للأمم، والحال أنه اللغة والأسرة والمدينة هي أهم ما أنتجت البشرية لتنظيم حياتها وشؤونها، ومازالت هذه المكونات الثلاثة تحدد على نحو حاسم هوية الإنسان ومواطنته ومكانته.