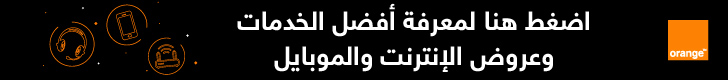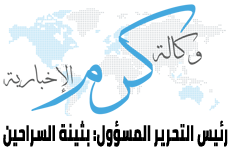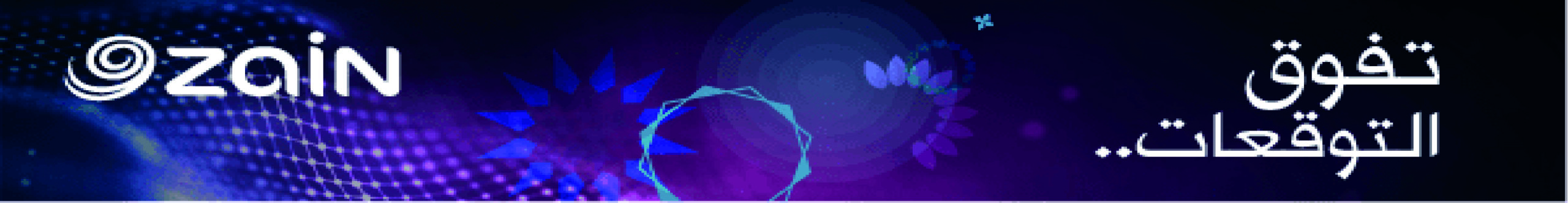“الوحدة الوطنية الفلسطينية… منظور مختلف”

بقلم:د.اياد البرغوثي*
يدعو الفاعلون الفلسطينيون الى “الوحدة الوطنية”، وضرورة انهاء الانقسام، كلما تحدثوا عن القضية الفلسطينية، أو أي جانب من جوانبها. والوحدة الوطنية عموما، هي هدف حتمي وضروري لكل الشعوب، خصوصا لشعب مثل الشعب الفلسطيني، الذي ما زال يرزح تحت الاحتلال، ويكافح من أجل تحرره، وتجسيد حقوقه الوطنية.
لكن المتابع لتلك الدعوات، وكذلك للمحاولات العديدة التي جرت لتحقيق تلك الوحدة، والفشل الذي كان نتيجة لكل المحاولات حتى الآن، يخلص لبعض الاستنتاجات، تتلخص في أمرين، الأول أن الفلسطينيين وخاصة حركاتهم السياسية، لا يملكون مفهوما موحدا لوحدتهم الوطنية، والثاني أن كثيرا من الحديث حول الموضوع، يجري في الهواء بمعنى أنه، أو على الأقل يعطي انطباعا، أن أصحابه مقطوعو الصلة بواقع القضية الفلسطينية، والتغيرات الجذرية التي عايشتها في العقود الأخيرة.
بدا موضوع إنهاء الانقسام، وتحقيق الوحدة الوطنية، كلاما مفرغا من المعنى الحقيقي له، مثقلاً بالبعد “القدري” الفاقد لكل الصلات بالواقع وبالمحيط، ولازمة لا بد منها للحديث عن فلسطين، تماما كما هي لازمة الشعر القديم الذي لا بد أن يبدأ ببعض “الغزل”، ومن ثم يذهب للموضوع المقصود.
طبيعة الانقسام
تتوج الانقسام الفلسطيني باستيلاء حركة حماس على السلطة في قطاع غزة عام 2007. وأصبح لدى الفلسطينيين سلطتين، واحدة في غزة، والثانية في الضفة الغربية.
لم تكن العلاقة الصدامية بين الحركتين الاساسيتين في الساحة الفلسطينية، وليدة تلك اللحظة، وإن كانت تلك ذروتها. فالخلافات كانت منذ اللحظات الاولى لتأسيس حركة حماس في نهاية 1987، بل وحتى قبل ذلك، عندما تمثلت الحركة الاسلامية في الضفة الغربية بالكتلة الاسلامية في الجامعات، حيث كان الصراع على أشده بين فصائل منظمة التحرير، خاصة اليسارية منها، وايضا فتح، وبين الكتلة الاسلامية.
اتخذ الصراع بعد تأسيس السلطة الفلسطينية إثر اوسلو منحى آخر، إذ أضيف الى الصراع الفكري الايديولوجي، والصراع السياسي على التمثيل، بعدا رؤيويا وبرامجيا له علاقة بالموقف من جوهر القضية الفلسطينية، والموقف من اسرائيل نفسها. وكذلك بعدا له علاقة بالموقف من السلطة، وأحقية كل طرف فيها، والمصالح التي تحصل عليها الأطراف، بناء على موقعها من السلطة.
لقد غير انشاء السلطة الفلسطينية في طبيعة العلاقات بين أطراف الحركة السياسية الفلسطينية الثلاث، فتح وحماس واليسار. فقبل انشائها شكل الاسلاميون ممثلون بحماس أساسا من جهة، واليسار من الجهة المقابلة، قطبي الصراع، لأسباب ايديولوجية على الأغلب، ومثلت فتح دور الحركة المعتدلة، واللاعبة لدور المخفف لحدة التوتر بين الجانبين الأساسيين في الصراع.
لكن وجود السلطة، و “هيمنة” فتح عليها، على اعتبار ليس فقط، أنها الحركة الأكبر وقائدة الثورة المسلحة، ولكن لأنها ايضا “صاحبة” المشروع (اوسلو)، وتموضع اليسار بشكل أو بآخر الى جانب فتح، كشريك صغير في السلطة، نقل الصراع من شكله الايديولوجي بين حماس واليسار، الى شكله السياسي بين حماس وفتح، والى صراع حول المصالح المباشرة المرتبطة بالسلطة. هنا لم يلعب اليسار، ولم يكن باستطاعته أن يلعب، دور الوسيط والمخفف للتوتر كما كانت تفعل فتح، إنما بدور “المؤدلج” للصراع، والمراقب له في أحسن الأحوال.
من الضرورة الإشارة هنا الى “اهمية” – بالمعنى الإيجابي هذه المرة – الفصل الجغرافي بين الضفة وغزة، ووجود كل سلطة في جغرافيا بعيدة عن الأخرى. فلو كان الوضع غير ذلك، بمعنى لو كان هناك تواصل جغرافي بين الضفة والقطاع، لكنا شهدنا حربا أهلية فلسطينية، ستكون الخسائر التي وقعت بين الفلسطينيين جراء احداث 2007 ، شيئا لا يذكر قياسا بضحاياها.
اضافة للصراع على السلطة، ووجود برنامجين وموقفين مختلفين من الاحتلال ومن اسرائيل نفسها، وللفوارق الايديولوجية بين الفريقين، فإن الصراع بين فتح وحلفائها وبين حماس، صراع تغذيه اسرائيل بطرقها المختلفة، كما تتحكم به علاقة الطرفين بالصراعات العربية والاقليمية، وموقف “المجتمع الدولي” واشتراطاته على الأطراف. ان الموقف من المجتمع الدولي له حساسية خاصة لدى السلطة الفلسطينية بسبب طبيعة المشروع الذي تتزعمه، وظروف المنشأ للسلطة نفسها.
متطلبات الوحدة
ان من يسعى لإيجاد وحدة وطنية فلسطينية، وإنهاء الانقسام، وهما بالمناسبة امران ليسا متطابقين تماما، يجب أن يسأل الأطراف الفلسطينية المختلفة سؤالين هامين، لا غنى عنهما للتقدم في الموضوع… هل تريد الأطراف المتنازعة الوحدة حقا؟، وفي حال كان الجواب نعم، هل تستطيع هذه الأطراف التوحد؟
فمن ناحية، لا يستطيع أحد مهما بلغ شأنه، أن يوحد طرفين لا يرغبان بذلك، ومن ناحية أخرى، أنشأت عملية اوسلو ليس فقط حالة من التبعية الفلسطينية لإسرائيل بحيث أصبح موضوع القرار الفلسطيني المستقل موضع تساؤل جدي، بل أسست ايضا لانقسامات عميقة حول المسائل الأساسية المتعلقة بفلسطين وقضيتها، ومن أبرزها مسألة الجغرافيا الفلسطينية، والحقوق الفلسطينية، ودولة اسرائيل.. هذه مسائل كبرى، فإذا اختلف الشعب على وطنه، فما هو ذلك الشيء الآخر الذي سيوحده؟
وحتى تصبح الوحدة الوطنية ممكنة، فمن المنطقي أن يكون لدى الفلسطينيين هدفهم الأسمى الذي لا يختلفون عليه، اذ يبدو أن اختلاف الأهداف العليا بين الأطراف الفلسطينية المتنازعة، وضع الفلسطينيين أمام أكثر من مشروع يتعلق بقضيتهم، وهذه المشاريع ليست فقط متعددة، بل ومتناقضة في أغلب الأحيان، بحيث يعتقد كل صاحب مشروع، أن عدم نجاح مشروعه يتمثل في وجود المشروع الآخر، وهذا بالعادة لا يقود الى الوحدة بل ما يتجاوز ذلك الى خلافات اكثر حدة.
فوحدة الهدف تعتبر القاسم المشترك “الأعلى” للوحدة الوطنية. وبالنسبة للفلسطينيين، تحتاج وحدة الهدف الى أقصى حد من الصراحة، ليس فقط مع الآخر، ولكن مع الذات أولا. فالصراحة تجعلنا نحدد السياق الذي نريد لوحدتنا الوطنية، هذا السياق الذي يبين لنا أية وحدة وطنية نريد، وهل ستكون هذه الوحدة في سياق مشروع تحرري مضاد للمشروع الاستعماري الصهيوني، أم هو في سياق آخر. لا أدري إذا كنت ابالغ إذا قلت، أنه في الحالة الفلسطينية يمكن اعتبار سياق الوحدة أهم من الوحدة ذاتها. فالوحدة خارج سياقها المؤدي للهدف الأسمى، قد تكون خطرا على المصلحة العليا للشعب.
ان من يحدد سياقنا للوحدة الوطنية الفلسطينية، ليس موقفنا من فلسطين، حيث كثيرا ما يكون الكلام عاما وضبابيا بشكل يجعل من الصعب التفريق بين الشعار والموقف، بل موقفنا من اسرائيل، ومدى الحرص على التخلص من تبعيتنا لها، او الاستمرار في الاعتماد عليها.
كما تلعب وحدة الهدف دورا حاسما في تحديد الوسائل لتحقيقه. لقد أدى “تشرذم” الأهداف بالنسبة للفلسطينيين، الى خلط كبير في وسائلهم وأدواتهم، تماما كمن يستخدم قطع غيار لمركبات مختلفة، لصنع مركبة ستكون أهم ميزاتها أنها لا تعمل. كذلك فإنه في حالة تعدد الأهداف وضبابيتها، ترتقي الوسائل لمرتبة الأهداف، حيث الصراع على الوسائل أكثر مشروعية، وفيه “راحة للضمير” أكثر من الصراع حول الأهداف.
في الحالة الفلسطينية كثيرا ما تستخدم وسائل لمشاريع مختلفة، وقد تكون متناقضة، لتحقيق هدف معين، فتكون النتيجة مخيبة للآمال، وبدون حاجة للتفصيل، يمكننا النظر الى استخدامنا لمنظمة التحرير والسلطة. ربما أن العلاقة بين الوسائل والأهداف، وتبادلهما للأدوار، تستحق دراسة معمقة، خاصة في الحالة الفلسطينية.
محاولات الوحدة
جرت محاولات عديدة لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، أو، وبشكل أدق، لإنهاء حالة الانقسام الفلسطيني. كان ذلك في القاهرة ومكة والدوحة وموسكو والجزائر.. – يعطي تعدد الراعين للوحدة وتنوعهم انطباعا، أن المشكلة فيهم وليس في المنقسمين – فنظرة الى الراعين وتوجهاتهم وتموضعهم الاستراتيجي تشير الى عدة ملاحظات؛ أن كثيرا من الراعين يعملون ذلك على ما يبدو، من أجلهم هم، اكثر من عملهم من أجل الفلسطينيين. وهذا بالمناسبة مفهوم ومشروع، فالمأذون يعمل من أجل نفسه، قبل أن يعمل من أجل تأسيس أسرة جديدة!!!
كما أن تعدد الراعين على اختلافاتهم، تشير، أو قد تشير، الى أن الفلسطينيين “غير جادين” بالقدر الكافي في موضوع الوحدة وإنهاء الانقسام، وأن الراعي الحقيقي الذي يستطيع التأثير بالقدر الكافي ما زال مفقودا.
هنا تكمن اهمية السياق الذي تجري فيه العملية، فالسياق الذي تأخذه محاولة الوحدة في الجزائر مثلا، غير ذلك السياق الذي يكون في القاهرة، أو موسكو أو مكة أو الدوحة. فكل طرف من هؤلاء، يرى القضية بمنظوره، ويريد أن يصل بها الى حيث يريد، في إطار تلك الرؤيا.
ان من يستمع الى كلمات الرئيس الجزائري، والملك السعودي، والأمير القطري، ووزير الخارجية الروسي، ومدير المخابرات المصرية، في افتتاح جلسات الحوار الفلسطيني للوحدة، يرى اننا امام سياقات مختلفة، وأوضاع مختلفة، واهداف مختلفة، إن لم تكن متناقضة في بعض الأحيان. ان تعدد الراعين وتنوعهم، وتعدد محاولات الوحدة، يشير من ناحية الى أهمية القضية الفلسطينية، لكنه يشير ايضا الى نوع من “اللا مبالاة” الفلسطينية، وقد يكون التعدد واختلاف التوجهات سببا اضافيا لعدم الوصول الى نتيجة ايجابية، فما يحرز من تقدم برعاية طرف، قد يتم فقدانه برعاية طرف آخر.
من الضروري ايضا أن ندرك أن اسرائيل، أو “الإرادة” الاسرائيلية، حاضرة بشكل او بآخر، في كل جلسات الحوار من أجل إنهاء الانقسام، وإن كان حضورا متفاوتا من لقاء الى آخر، وذلك بسبب “العلاقات” التي لا يمكن تجاهلها بين اسرائيل والراعين لتلك اللقاءات باستثناء الجزائر.
لا يعني ذلك بالتأكيد، أن الراعي ليس له لزوم في حالة الانقسام الفلسطيني، بل قد يكون دوره غاية في الأهمية، خاصة أن العصمة في هذا الموضوع بيد كثيرين. لكن الأساس في ذلك هو الإرادة الفلسطينية، وتوجهها الجدي لتذليل الصعوبات، ثم تأتي أدوار الأطراف الأخرى.
اضافة الى كل ما تقدم، فإن جل الحلول التي طرحها الوسطاء الداخليين أو الخارجيين، لا تذهب الى جوهر الموضوع، وهو برأينا الاتفاق على الهدف، ومن ثم اختيار الأدوات المناسبة للوصول اليه، بل ذهبت الى التفاصيل المتعلقة “بإصلاح” المنظمة، بمعنى إيجاد صيغة أخرى للمشاركة والتشارك فيها، أو إيجاد حكومة وحدة وطنية، رغم أن الانقسام الكبير جرى في ظل حكومة الوحدة الوطنية، أو بالدعوة للانتخابات والاحتكام للشعب، على الرغم من أن الانقسام جرى إثر الانتخابات التي لم يرض “المجتمع الدولي” عن نتائجها.
الى أن تتحقق الوحدة.. ما العمل؟
يتضح مما تقدم، مدى تعقيد مسألة الوحدة الوطنية الفلسطينية وتشابكاتها، ومدى أهمية تذليل الصعوبات أمامها، وتهيئة الظروف لجعلها ممكنة، فالعصمة في الحالة الفلسطينية بيد كثيرين، والقوى المعنية باستمرار الانقسام ما زالت اقوى من تلك المعنية بإنهائه.
في ظل هذا الوضع، على الشعب الفلسطيني عدم انتظار زعمائه لكي يصنع وحدته، بل عليه اجتراحها على الأرض، بعيدا عن انقسامات النخب السياسية، وهذا ما نراه بالفعل في الميدان، وفي الحركات المطلبية لفئات فلسطينية مختلفة.
أما بالنسبة للقيادات والجهات المنقسمة، فيجب عليها أن تدرك أن الوضع الحالي على صعوبته، لا يتطلب الاستسلام للانقسام واستمرار الصراع بين اطرافه، فبين الوحدة والصراع مسافة كبيرة، يفترض أن يذهب لها الطرفان، لخدمة المصلحة الفلسطينية العليا كل من موقعه، في ظل “هدنة” بينهما يتفقان على شكلها وآلياتها، ذلك يتطلب لقاءات وحوارات بينهما، ربما سيكون افضل لو كان ذلك بدون رعاية أو وسطاء، وبعيدا عن وسائل الإعلام، للاتفاق على ماهية المصلحة العليا، وتحديد مساحات الاتفاق بينهما ومساحات الخلاف، لضبط ذلك الخلاف، وربما “للاستثمار” فيه. فمن قال إن كل وحدة مفيدة، وكل فرقة ضارة، وفي كل الظروف؟ ان ذلك هو القاعدة بالطبع، لكن الاستثناء وارد، بمعنى يجب خلق الطريقة التي نستفيد منها حتى في ظل الانقسام.
في قضية مثل القضية الفلسطينية، المعقدة بقدر ما هي محقة، من واجب الفلسطينيين بكافة انتماءاتهم الفكرية والسياسية، أن يعملوا على نصرتها في كل الحالات، وأظن أن “التنسيق” بين المختلفين من أجل ذلك، مسألة تستحق المحاولة، الى أن تأتي الظروف بما هو أفضل.
*أكاديمي فلسطيني
“عن الأخبار اللبنانية”