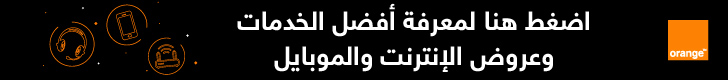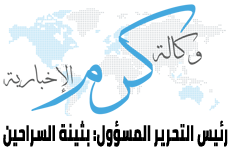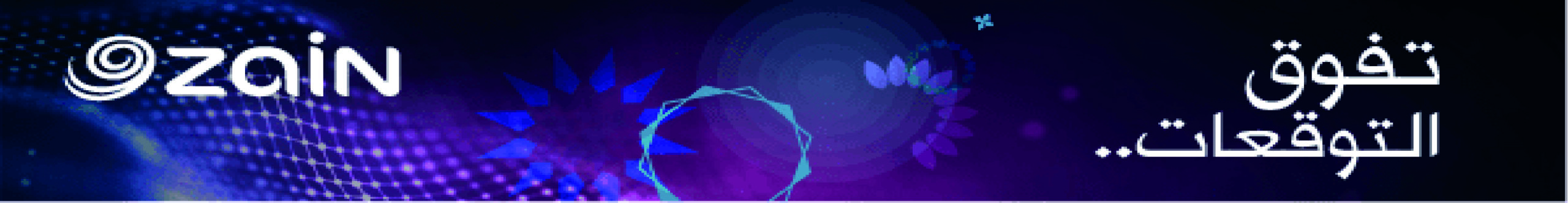اللجة البيضاء.. قراءة انطباعية في ديوان (درج العتمة) للشاعر هشام عودة

بقلم: د. زاهر محمد حنني
جامعة القدس المفتوحة
خِلْتُ أَنَّني أَمسَكْتُ طَرفَ الخيطِ وَأنا أقرأُ ديوانَ هشام عودة الجديدَ (درج العتمة)، عندما تحسَّسْتُ آلامَهُ، وَصَعَدْتُ مَعَهُ الدرجَ درجةً درجة، بعدما وَلَجْنَا عَتَبَةَ النصِ، وتفيأنَا ظلالَ (سما) أبي الطيبِ، وعندما وصلتُ (مَعَهُ) أعلى الدرجِ انهارتِ القمةُ، وَضِعْنَا في متاهاتِ العتمةِ، فأمْسَكَتْ (سما) بأيدينا لتدلَّنا معًا على الطريقِ.
سنة 1992 زرتُ أبا الطيب في شقته المتواضعة في بغداد، وخلت أنها كانت في الطابق الثاني، وأنها كانت في الشطر الجنوبي من البناية السكنية، تعرفت عليه للمرة الأولى آنذاك، وكان برفقتي صديق من غزة هو الذي عرفني به، وبعدما قضينا وقتا لا أنساه، في حوار كان أكثره حول مجلة (الثائر العربي) التي كان أحد أبرز أعمدتها، غادرْنا، واختلفتُ مع صديقي، هل كانت الشقة في الشطر الجنوبي من العمارة؟ وهل كانت في الطابق الثالث؟ولم أعاود الزيارة آنذاك لأتيقن ما إذا كانت في الطابق الثاني وفي الشطر الجنوبي. لا أعرف لماذا عادت الفكرة تلح على ذاكرتي الآن، بعدما قرأت (درج العتمة)!!
لن أستعين بتوزيعاتك -يا أبا الطيب- التي أبهرتني؛ لأنني سأعيد توزيعها، وفق مشيئتي هذه المرة، فلتأذن لي.. إذا وافقت، فاقرأ شغاف روحك في هذه الكلمات،وإلا.. فأرسلها مع الريح كأنها لم تكن. فمنذ (هي امرأة ينام الليل فوق ذراعها…) إلى آخر نبض في (سوف أطيل السهر.) رسمتَ خطوطًا للقلقِ، وأنا ترسمت تلك الخطوط، ووزعت الخطوات، فكانت:
أولا: سما..
سما ليست ابنة الشاعر، بل هي ابنتي، وابنتك، وابنة الوطن، ونبض الكلمات، ورمح الحرف، وصوت القلق، وسوط الحق، هي الشعاع الوحيد في عتمتنا، التي تضيء مجاهيل الليل والطرقات، حتى غدت أيقونة في شغاف قلب الشاعر النابض، وربما يكون الاسم ذا دلالة سيميائية فاحتل مساحته الخاصة في الإهداء، ولم يتكرر الاسم في الديوان، ولكنه كان عصا الترحال، وبه يهش الشاعر على راعفات الهوى، فتغدو بلسما للأرض وهي سما، بها يلوذ الحائرون إلى أن يهتدوا، وبها عبير كل شيء؛ عبير الكستناء، وعبير الوطن، وعبير العشق، وعبير الحضور، وعبير المرأة. الغريب أن سما لم تُرِدْ شيئًا، وأراد لها الشاعر؛ لأنه رآها بقلبه وعقله ومشاعره، فأراد لها، وهو يستظل بعينيها، ويفرش لها القصيدة بساط ريح. سما بصيرة الشاعر.
ثانيا: الليل..
مجازًا أو حقيقة هو الليلالذي يتبادل الأدوار مع العتمة، وهو صِنْوُهَا، ينصب شباكه على الديوان منذ عنوانه، مرورا بكل تجلياته، وصولا إلى حواف القلق. الليل يهزم الضعفاء، ويهزم الخائفين، ويهزم المارقين، ويهزم الرائين بعيونهم، ولكنه لا يستطيع أن يهزم الرائينببصيرتهم. ويظل ثمة فرق بين الليل والنهار حتى عند من انطفأ مصباحه، لأن الليل يعني ما يعنيه، وهو طريد جنايات النهار. وحين يصير الليل إحساسًا، تُعْلَنُ الثورةُ التي تدمرُ دياجيرَهُ، وتنتفض الأركان؛ عيون الحبيبة والرفيقة، مشكاة الدم، نسغ القلب. وحين يجتمع ليل الليل وعتمته، يبدأ المد بالانحسار، وتبدأ الهزيمة والانكسار، ويعبر عنها الشاعر بالوحدة، والوحدة نظير الغربة، في ليل معتم.
هل هزمك الليل يا أبا الطيب، حتى قلت:” الليلُ لي”؟ أم أنك تعاود التناص مع درويش حين استنكر أن يكون الليل له فقال على لسان بيروت(كلُّ هذا الليلِ لي؟ والليل ملح).لم تخذلني.. فقد اكتشفت أن الليل لك (شجر يعيد لنا بريق حياتنا/ ويموج مثل سنابل خضراء/ في حقل تعانقه السماء) تلك إذن هزيمة أخرى لهذا الليل.
ولما صار الليل في أوج ظلمته، راح الشاعر دون مراوغة إلى معاودة السير في الطريق إلى القدس، فهل الليل هو ليلنا جميعا؟! ونحتاج إلى كف تلاطم مخرزا؟ ريحانة تملأ الجو عطرا، الحجارة والطين والفجر والراية العالية، وأمام الفراشات الحيرى، تُغْلِقُ النافذةَ و…تنام؟! لله درك! كيف أشعلت المدى! وتركتني رهن صولجان ليل المدينة الغامض! كيف فعلتها؟ أعميت عيني، وصرت أنت المبصر، وعين الشاعر لا تصاب بالعمى.
ثالثا: الوطن..
طاقةُ الإيحاءِ، وقوةُ الإرادةِ، الهزيمةُ المتواصلةُ في مسلسلٍ طويلٍ مُدمى، العشق الأزلي الأبدي السرمدي، عشاقه كثيرون، منهم من يعشقه عشقا عذريا كجميل بن معمر الإيادي، ومنهم من يعشقه عشقا حسيا كعمر بن أبي ربيعة، ومنهم من يظن أنه يعشقه، ومنهم من يدعي أنه يعشقه، وأنت.. أنت وحدك، من جعله مكللا بالنهار، وجباله على حد صخرتها واقفة، تكحل جفن السماء بزيتونه، تصوره كيف يزرع الشهداء بصمت، كي يظل مرتديا ثوب أمك، متحدا مع جماليات روحك التي ترنو أن تظل بين أرضه وسمائه.
الندى، البلاد، الصدى، الطرقات، عيونها، خيط المدى، هو ما تراه يظل وطنا غارقا في عيون الصغار، كي نظل معا، ولا الردى. الوطن حين تتعانق القدس والخليل وكفل حارس مع بغداد والكرخ والرصافة والأعظمية، فتحط ذرات التراب على رصيف الذاكرة، وترسم وطنا يتجلى في ملامح الولد المتيم بالقصيدة.
رابعا: الأم والذكريات..
أينما وليت وجهك، كل أم في قصيدة، وكل قصيدة في أم، فهي احتضان الروح في نبض القصيدة، ومشاعر العشاق في زمن الهزيمةوالنقوص، ودوحة المنفيِّ في ليل عبوس، ريحانة البقاء، زيتونة التجلي، راعية صائد القبرات، رفيق الفراشات، إلى أن يصير قاطف النجوم من عاليات الشجر، وإن قدر له أن يعود، فسيظل حاملا في يده قبضة من هواء، وليس من خواء.
كل ما في الأمر أن الأرض واقفة تشير إلى السماء، ولا شيء يشبهنا في ازدحام الطريق، سوى ظل دالية لا تشيخ، هي التي نذرت عمرها للغناء، حتى صرنا، وصارت لأسمائنا هيبة في ثنايا الكلام. هي التربة الطاهرة.
قبل النساء جميعا، أول قافية في قصيدة العمر، والدروب إلى قبرها مسيجة بالحنين المقفى، … وقد أثقلتها السنين. حنانيك يا مبدعة الرؤى في ظلام الكهوف، حنانيك يا من تسيجين عمري بهدبك والرموش، لا شيء يعيد الذكريات، ولكنها تستعاد، فإن تم، وإلا فلا حسرة عليها ولا هم يحزنون.
خامسا: الموت..
للموت معادل قهري في حقول الذاكرة، وله حضور ممض في درج العتمة، الموت: موتي، موتك، موتها، موته، الموت هو الموت، يجتاحني قلقي/ فأكتب للشوارع والحجارة/ ما يليق بلحظة حيرى. الوحدة، العتمة، الليل، الموت، أخالها طرقا أربعة لمصير واحد، أو لنهاية واحدة، فالوحدة والعتمة والشبّاك الأخرس، تعجل بكتابة مرثاة لدموع النهر.
كتبت ذات مرة، (الموت يصفعنا في كل مرة، صفعة تهز ماضينا كله، الموت زلزال يدمر أركاننا فيتركنا بقايا نتخبط في ظلمات اللامعلوم. وقبل أن نبدأ بلملمة ما تبقى من هيكل الجسد ندرك – وقد لا ندرك – أننا ما زلنا لا نعرف ما بعد الحافة؛ فالموت بعد حافة نراها ولا نعرفها، ما قبلها مرتبط بأسئلة وجودية كثيرة لا حصر لها، وما بعدها مرتبط بأسئلة غيبية أكثر، لا جواب لها في حدود معرفتنا المادية.كل ما أتاح لنا الله – تعالى- أن نعرفه ونصنعه، أتاح لنا القدرة على تمييز خصائصه وربما العبث بها إلى درجة اللهو أو الاستعباد أو التملك أو التغيير فيه، حتى وصوله، أو وصولنا، إلى تلك الحافة. التي يبدأ بعدها الغيب والمجهول الحقيقي. كيف يكون مجهولا وحقيقيا في الوقت نفسه!؟ لا أحد يملك إجابة قاطعة في هذا الشأن.الموت جواب لا سؤال له، كيف.. لماذا.. متى.. أين.. كلها عبثيات نحاول أن نتستر بها على جهلنا، الجهل بماهية الموت هو الجهل الوحيد الذي ينبغي ألا نخجل منه. وأن نعترف به باعتزاز.نعرف من الموت أنواعا كثيرة، لكننا لا نعرفه. نعرف من أنواعه ما يتركنا وسط النيران تلتهمنا رويدا رويدا، وما يتركنا أسرى هواجس تعبث بنا ثم تمضي بنا إلى حتفنا، وما يتركنا حيارى.. وفي كل مرة يتركنا أجهل مما كنا فيه).
في درج العتمة يصير الموت ظلامًا في ثنايا الحضور، وحدةً تلاحق بطلًا وتحاصره، وجميع ساعات الفتى ليل مباح، منذ انطفأ المصباح، وبلل صدأ الكلمات الجوارح المتعبة.
سادسا: التيه..
ضاعت أمة من محيطها إلى خليجها وهي تبحث عن نفسها، وتسربت كل دروب التيه إلى مفاصل كينونتها، ومنها وفيها يعبر الشاعر الحاذق عن تفاصيله، وتفاصيلها، ويجد نفسه يعوم في بحر ضياع ليس له قرار، ولا تحيطه شواطئ يرسو عليها، فيخلق فيه عالمه، ويبدع في تصويره، لكنه العالم الافتراضي الذي لا يمكن للشاعر أن يعيش فيه حياته، ولكن يعيش خياله فيه، لذا فإن الفجوة المنطقية بين الواقع والخيال تظل تطرق على قشرة الدماغ. ليس في درج العتمة عالم افتراضي بهذا المعنى، ولكن فيه عالم الشاعر، فمن أراد أن يضيع في بحار التيه، فيمكنه ذلك، وإذا أراد أن يعيش في عالم الواقع فله ذلك أيضا، ولشدة التيه الواقع في العالم المعاصر صار العاقل يبحث عن عالمه الخاص، ويرسم حدوده، ويحدد ملامحه وفق ما يرى.
هشام عودة يطرق على قشرة الدماغ بشدة لتصحو أمة أغرقت في سباتها، ويكتشف –ليس متأخرا- أن العالم ضياع في ضياع، ولعل أبرز ملامح التيه ما يتعلق بقضيته وتناقضات العالم الإجرامي، وظلمه، فيظل الحب مفتاحا لكل مأساة، والعشق طريقا للوصول، والانتماء سبيلا لا بديل له. ولكن الشاعر لا يرحم الظالمين والمعتدين والمتآمرين والمندسين والخونة والمتسلقين ومن سار على دربهم، ويتماهى مع المخلصين المناضلين المنتمين، ويحافظ على بوصلة لا تغير مسارها، ولا تنحرف. لذا وسط الضياع والتيه يجد الشاعر طريقه الذي برغم –الظلام- ما زال يراه بوضوح تام. على الرغم من أنه ما زال يبحث عن وطن يشبهه في ليل أعمى، أو عن وطن يشبه الأرجوان البهي، ويكتب عن رحلته في طريق المحبة نحو أعالي الجبال.
سابعا: الحبيبة…
هي الخيط الممتد من همسات الروح وشغافها، مرورا بجنبات الهيام وانعكاساتها، ومدارج الأفلاك وامتدادها، ونجوم الحلم، ورف العصافير، وأحلام طفل تعلق بأهداب وطنه، وأب ينام ليستريح، وأم يغالبها العمر، وصولا إلى رفيقة يتقاسم معها حلو الأيام ومرها، ويسكن إليها، ويتحد معها في همسات الظلال الندية، وأحلام العشق الوردية، وتصير حياة، ويصير عاشقها الأبدي.
هي الرابط بين كل مفاصل العمر ومحطاته، وهي الحبيبة التي يظل الشاعر يحاول رسم ملامحها. ترى هل تغيرت تقاسيم وجهها بعد أن انطفأ المصباح؟ وهل من الطبيعي أن يزداد تعلقه بها؟ لا أدري!! وربما أدري..
الأرض حبيبة، الأم حبيبة، الابنة حبيبة، الأخت حبيبة، الزوجة حبيبة، الحبيبة حبيبة، إذا رأيتها، أو أحسست بها، أو سمعتها، أو شممت عطرها، لا فرق، فهي الحبيبة. في حلك وترحالك، في حضورك وغيابك، في هدوئك وغضبك، في حزنك وفرحك، تظل هي الحبيبة.
وهكذا تصير الحبيبة كل شيء أينما وليت وجهك فهي هناك. وكذلك في درج العتمة، هي في كل مفاصله، وصوره، وإيقاعاته، وتناصاته، هي في كل حرف فيه.
قبل الختام..
سطور الشاعر هشام عودة في (درج العتمة)، ليست سطورا شعرية خالصة الجمال وحسب، إنها تأخذك وتطوف بك في فضاءاتها، فتعيشها، وتتماهى معها، تحب، وتفرح، وتحزن، وتعود إلى الوطن، ثم تجبر على مغادرته، تسير في شوارع بغداد التي لم تغادر ديوانا من دواوين الشاعر، حتى تصل القدس التي ظلت أيقونة بقاء في ضميره، وتصل إلى كورونا الجائحة لتعرف أنها ليست فرصة سانحة، تنتقد، تعبر عنك وعني وعنا، ويتنقل بك من التفعيلة الواحدة إلى البيت، ولا يشعرك أن الأمر اختلف، فتدرك أن الشعر مهما كان قالبه فإنه يظل شعرا يمكن أن يحلق بك إلى عالمه، ويطوف بك في فضاءاته الجميلة.
هشام عودة بعد هذا كله –وهذا غيض من فيض- صادق إلى حد الاتحاد معك فيما تود أن تقول، فدعه يعبر نيابة عنك.
د. زاهر حنني