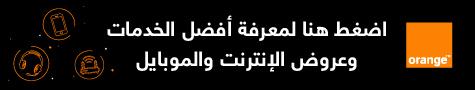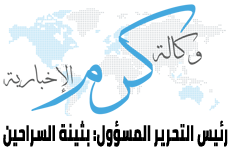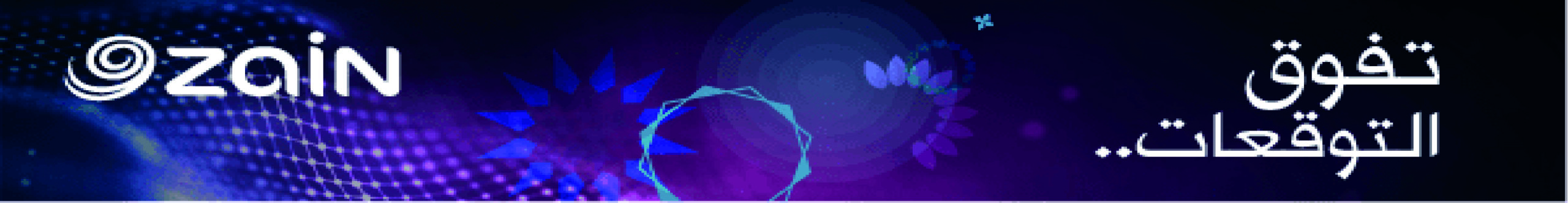“الدولة” التي تعبث بالعالم

بقلم: الدكتور إياد البرغوثي*
اسرائيل “دولة” ليست ككل الدول، كونها بالأساس نتيجة “مشروع” ثم حاملة لذلك المشروع فيما بعد. انها دولة “مخلوقة” من لا شيء، اذ لم يكن متوفراً أيٌ من “عناصرها” عند بداية “التنفيذ”، فكان لزاما توفير كل شيء، الأرض والشعب والنظام والجيش والثقافة واللغة والقوانين… كل شيء.
ولأن اسرائيل نتيجة مشروع من نوع خاص صممه أصحابه ليكون أبديا، لذلك هي في “مهمة” لا تنتهي، فيتم الحرص على “شحنها” باستمرار، وامدادها بكل اسباب الحياة و”التفوق”.
وحيث أنها دولة مخلوقة من لا شيء، وهذا في بعض جوانبه إقرار بعظمة “خالقها”، فهي تحمل صفات “جينية على الأغلب”، تجعلها مختلفة عن باقي الدول؛ فهي دولة عنصرية انعزالية قبل قيامها وليس في سياق تطورها اللاحق. والعنصرية الاسرائيلية “تفوق” وليس مجرد اختلاف، وهو تفوق معطى سلفا ومُحَمل بالكثير من القداسة. ولا يقتصر ذلك التفوق عليها كدولة بل يمتد الى الأفراد، فالاسرائيلي متفوق على أي انسان آخر وليس على الفلسطيني فقط، بل ان الآخر لا قيمة له، وفي بعض الحالات لا وجود له.
“خلق” اسرائيل في سياق هذا المشروع وبهذه الطريقة التي تمت بها، جعلها اقرب الى “الروبوت” من أي شيء آخر؛ فهي تريد أن تكون استثنائية في قوتها، ممنوع عليها أن تبدو ضعيفة، لذلك تذهب الى “التوحش” عندما ترى ذلك ضروريا، وهذا يفسر “ضرورة” تحسسها المستمر لوجودها، فهي لا تكتفي بالوجود بل باستمرار التأكد منه والتأكيد عليه. واستثنائية في ذكائها، وهي بالفعل كذلك إلا في الحالات التي راهنت فيها على الغباء “الدائم” لأعدائها.
والدولة “الروبوت” صفر مشاعر وصفر تسامح، فليس لغيرها أي حق، وإن أعطت شيئا لسبب ما فذلك بالنسبة لها امتيازات تمنحها وليست حقوقا تعيدها.
إنها كذلك دولة كالوجبة “السريعة”، لا يدل شكلها على جوهرها، تحرص على نجاعة “التسويق” الذي لا يعني جودة المحتوى، وتريد فرض “حبها” على الآخرين رغم محتواها “القاتل”.
انها لا ترضى برأي آخر وتسعى الى امتثال الآخرين لوجهة نظرها وروايتها وأن يجدوا في “تميزها” شيئا طبيعيا، هي باختصار لا ترضى إلا بصهينة العالم.
لقد ارتاحت لظلم الفلسطينيين، ولم تستطع ايجاد طريق “لسعادة” الإسرائيليين أو “لوجودهم” بعيدا عن اضطهاد الفلسطينيين الذي لا يعنيهم بشيء.
اسرائيل مقتنعة كليا باستثنائيتها، لذلك فإنها تبني على تلك الاستثنائية كل سياساتها ومواقفها، ومستعدة لعمل أي شيء للحفاظ عليها. هذا أوجد عندها فهما خاصا للزمن، فهي تستقطع من التاريخ ما تشاء، وتتجاهل ما تشاء. لها روايتها الخاصة عن تاريخ فلسطين القديم، فتعتبر فترة انشاء مملكة يهودا القديمة التي استمرت لثمانين عاما بداية تاريخ فلسطين، واعتبرت ما قبل انشاء تلك الدولة وما بعده لا شيء. لم يكن قبلهم أحد ولم يكن بعدهم أحد.
هذا حدث ايضا في روايتهم عن “الطوفان”، فتبدأ الرواية من ذلك اليوم ليبنوا على الأمر “مقتضاه” كأنه بداية الصراع، ويصنعون روايتهم وليس أمام الآخرين إلا تبنيها والإيمان بها.
وهي استثنائية في “توحدها” (بالمعنى المرضي) وتعاملها مع الآخرين بناء على ذلك. فهي لا تريد أن تكون عضوا في الاتحاد الأوروبي لكنها تريد أن تُعامل من قِبله أفضل من دوله. ولا تريد أن تكون عضوا في حلف شمال الأطلسي لكنها تريد أن تحظى بامتيازات فوق ما يحصل عليه الأعضاء. احيانا تريد قوات للأمم المتحدة لكنها لا تريدهم في “اراضيها”، وتريد خوض الحروب لكن خارجها. لا تريد أن تكون مع أي أحد لكنها تريد من الجميع ان يكونوا معها أو خلفها.
ليس لدى العقل الاسرائيلي احترام لأحد، فهي (إسرائيل) مستعدة لأن تهاجم من تشاء حتى اولئك الذين قدموا لها الخدمات، فتلغي الاونروا رغم أنها مؤسسة دولية تأسست بقرار دولي، وتعتبر الأمين العام للأمم المتحدة شخصية غير مرغوب فيها، وتضرب اليونيفيل في جنوب لبنان، وهي لا تعتبر نفسها مسؤولة عن أية “آثار جانبية” قد تترتب على عملياتها.
اسرائيل تتصرف بناء على “منطق” خاص لفهم القيم، وهي ليست مضطرة للنظر في “صحة” سلوكها فهو صحيح بالتأكيد ما دام هو سلوكها، فما تقوم به هو الخير ولا شيء غيره. وهي لذلك لم تقم بتقييم اخلاقي لعملياتها ولو مرة في تاريخها، بل كل ما تقوم به هو تقييم مهني لاستخلاص العبر من أجل أن تكون عملياتها القادمة اكثر “نجاعة”.
لذلك لا ترضى اسرائيل إلا بـ “المطلق”، تحارب من أجل النصر المطلق كما يقول نتنياهو، ولا ترضى إلا بإيمان كلي بروايتها، بل هي تؤمن أن لا رواية إلا روايتها. وهي لا تؤمن بالحوار ما دامت تعتقد أن الحقيقة (والعقل والله) تُعرف بها؛ فالحقيقة هي ما تقوم به والعقل هو ما تؤمن به والله هو “رب” اسرائيل.
لذلك هي من يحق لها أن تقول رأيها في الآخرين وليس العكس، وهي التي تطرد الأمم المتحدة (الاونروا) منها وليس العكس، وهي فقط التي تملك الحق في “الدفاع” عن النفس بالشكل الذي تريد وبالمستوى الذي تريد. هذا يعني أنه ليس مطلوبا منها أن تقترب من الآخرين بل مطلوب من الآخرين “الارتقاء” الى فهم ضرورة التقرب منها.
بقي أن نضيف في هذا المجال، أن ما ينطبق على اسرائيل كدولة في مجال عنصريتها و”استثنائيتها” ينطبق ايضا على الفرد الاسرائيلي وعلى من هو مرشح ليكون اسرائيليا. فالاسرائيلي هو أهم وأرقى وأذكى و”أقدس” وأغلى من أي انسان آخر. لذلك فالحق الى جانبه دائما، والحماية له والأولوية له والتسهيلات له والمشاعر مقتصرة عليه. هو من يصاب بالهلع اذا سمع صوت انفجار، والآخرون يكذبون اذا أبدوا أية مشاعر تجاه آلاف القنابل التي تسقط على رؤوسهم.
هو من يحاكم الآخرين ولا يحق للآخرين محاكمته، وهو من يستطيع الدفاع عن نفسه كما يريد مثل دولته. وهو الذي يُقَيّم في شركات التأمين أغلى من أي انسان آخر وإلا تم اتهامها باللا سامية. هذا ما يفسر مبادلة الاسرائيلي بأكثر من الف فلسطيني (حتى وقت قريب)، وهذا ايضا ما يفسر “حرص” الدولة على “الوقوف” مع مواطنيها أينما كانوا ومهما فعلوا، كما حصل مع مثيري الشغب الاسرائيليين في أمستردام مؤخرا.
“الطوفان”.. ضربة للاستثناء
“جريمة” الطوفان، أنه هز صورة اسرائيل، هز “استثنائيتها”، وأرجع الأمور الى البدايات (النكبة) بعد أن كادت الأحداث تخفيها تماما، وتذهب بها الى مساحات غير تلك التي ينبغي أن تكون فيها. عادت الأسئلة الأساسية لشعب تم اغتصاب حقوقه في وضح النهار ولم يعترف بصرخاته كل المشاهدين، ولمشروع اعتقد انه أجهز على ضحيته، وامتلك كل متطلبات بقائه.
في ذلك اليوم بدت اسرائيل قابلة لأن تكون أقل ذكاء، وأقل تفوقا، وأقل قوة، وظهرت جليا قابليتها للانكسار. في نفس الوقت، بدا اعداؤها أقل “غباء” مما اعتقدت، وأكثر قوة مما اعتقدت.
اهتزت اركان المشروع. والدولة التي وُجدت لحمايته احتاجت لمن يحميها، وتلك التي تعاملت على اساس أنها منتجع ومعسكر، منتجع يقضي فيه “الاستثنائيون” أوقاتهم في جو من النقاء و”الطهارة”، بعيدا عن مثيري الاشمئزاز من الأغيار “الدون”، اصبحت المكان الأكثر جلبا للمتاعب لهم. ومعسكر يقوم بأداء مهامه في الحفاظ على “الاستثنائيين” وعلى “المشروع” بكل كفاءة فإذا به بحاجة الى من يحافظ عليه.
ضرب الطوفان كل قواعد “الاستثناء” الاسرائيلية. وكل أركان المشروع الصهيوني. في ساعات عادت هذه الدولة “المتفردة” في “ذكائها” و”قوتها” و”ديموقراطيتها” الى دولة مثل باقي الدول، ولم يبق من عناصر “تميزها” على الآخرين الا توحشها ولا معقوليتها.
هذه الدولة الاستثناء التي دأبت على الحرص على مواطنها الاستثناء، وجدت نفسها تساوم على “قيمته” في مفاوضات تبادل الأسرى، ووصل بها الأمر الى “التضحية” به وحتى قتله من أجل استرجاع صورتها. كانت دولة المواطن اليهودي فوجدت نفسها تقتله من أجل لا معقولها.
أبطل الطوفان قدرة اسرائيل على “التمثيل”، فالتي كانت تفاخر بديموقراطيتها الوحيدة في المنطقة، اخذت تلاحق مواطنيها على رأيٍ في وسائل التواصل الاجتماعي، وتم فصل موظفين من وظائفهم وطلبة من جامعاتهم بناء على ارائهم. لقد اصبحت دولة نزقة، لا تتحمل أي شيء ولا تطيق أية معارضة ولا أي اختلاف حتى لو كان ذلك من وزير جيشها نفسه.
إسرائيل… تهديد متصاعد
لم تترك الحرب الاسرائيلية الحالية على غزة ولبنان أي شك في أن اسرائيل متشبثة في “استثنائيتها” ولا معقوليتها الى النهاية. وهي لا ترى من أجل استمرارها في ذلك إلا ممارسة مزيد من اللا معقول يتجلى في احتراف أكبر للقتل، وارتكاب المزيد من المجازر وإظهار المزيد من الوحشية. بخلاف حروبها السابقة، وفي محاولة منها على ما يبدو لاستعادة صورة “الردع”، حرصت اسرائيل على أن يكون لا معقولها بيِنا وعلى رؤوس الاشهاد.
لا يسمح “الاستثناء” الاسرائيلي لهذا النمط من الدولة، بالتفكير في طرق بديلة لحل مشاكلها ومعضلاتها التي لا تسير الا في خط تصاعدي، لذلك فهي تحل “معضلة” الاحتلال بالمزيد من الاحتلال، ومعضلة ارتكابها للجرائم بارتكاب مزيد منها، ومعضلة وجود ضحايا لاعتداءاتها الى إيجاد مزيد من الضحايا.
اسرائيل اللا معقولة اظهرت انها دولة “خفيفة” ورعناء ولا تملك أي حس بالمسؤولية تجاه العالم. ضاعفت في هذه الحرب ضحاياها من الفلسطينيين واللبنانيين والعرب والمسلمين وحتى الاسرائيليين، و”حرضت” الحكومات الغربية على مواطنيها وشبابها وطلبتها وأصحاب الرأي فيها، وأساءت للأمم المتحدة وسكرتيرها العام ومؤسساتها وفي مقدمتها المحكمة الدولية الأهم.
وإضافة لذلك، فإنها تعبث بالتاريخ وبالجغرافيا والقيم والمنطق والأعراف وبكل ما هو انساني. واذا ما أضفنا الى ذلك، وفي سياق الارتباط “الغربي” الأعمى بها، أخذت الولايات المتحدة والأنظمة الغربية الى اللا معقول ايضا، وهذه بدورها أخذت المنظمة الدولية والنظام العالمي برمته الى نفس الحالة، فهل يُعقل أن يصوت أرفع مجلس أممي مسؤول عن السلم العالمي ضد وقف إطلاق النار ومع استمرار ارتكاب المجازر والإبادة… نحن أمام حالة مذهلة من اللا معنى.
في مثل هذه الحالة، من يستطيع ضبط رد فعل الضحايا؟. ومن يستطيع ضمان استمرار الحالة التي تمارس فيها الضحية قمة العقل وضبط النفس ويمارس الجاني و”غربه” قمة الجنون؟. ربما اذا استمرت هذه الحالة فإن الأبواب ستفتح نحو اللا معقول على مصراعيها، وستقتنع الضحايا أن لا مجال للعقل للتعامل مع هكذا “جُناة”، فإذا كان الجاني مستعد لضرب ضحيته بالسلاح النووي، فمن الذي يضمن أن الضحية سوف لن تذهب بتفكيرها الى ما يتناسب مع ذلك…؟
*باحث وأكاديمي فلسطيني / رام الله