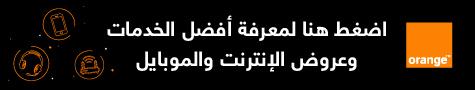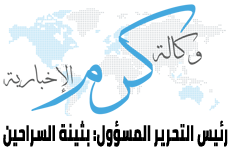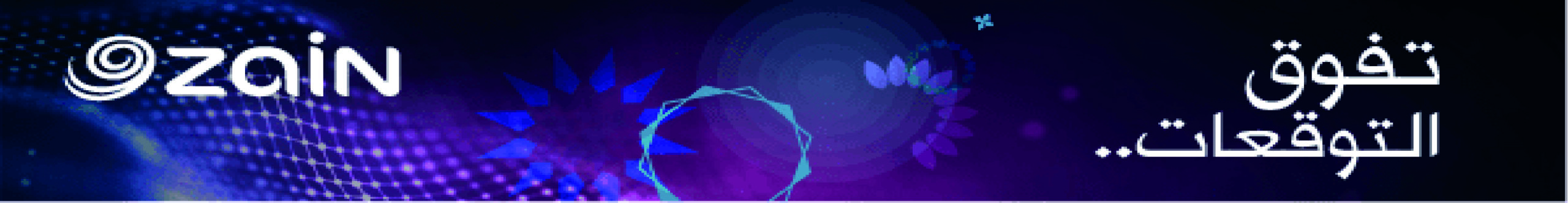إحسان عباس الناقد الذي وُلِدَ من عينَي غزال مرّتين!
المهندس الفلسطيني الشاب، الذي قطع أكثر من بحر، وقاوم أكثر من موت، كان يجلس في مقهى صغير في مدينة ماسترخت الهولندية. كل شيء كان آمناً بالنسبة له، بعد أن وجد عملاً وأصبح له بيت غير ذلك الذي دُمِّر في مخيم اليرموك، لكن الشيء الجميل الذي حصل أنه سمع من يتكلمون اللهجة الفلسطينية على بعد طاولتين منه، فنهض فرحاً كما لو أنه ذاهب للرقص. المهندس الفلسطيني الشاب سألهم: أنتم فلسطينيون؟ فأجابوا: «أجل. وأنت؟». «أنا فلسطيني أيضاً؟». «من أين؟». «أنا من بلد إحسان عباس».
في ظني أن هذا أكبر تكريم يمكن أن يحصل عليه الكاتب حيّاً على قيد الحياة، أو حياً رغم الموت.
كتب إحسان عباس الذي ولد في قرية «عين غزال»، وتقع إلى الجنوب من مدينة حيفا، سيرته «غربة الرّاعي» وفيها الكثير عن تلك القرية، كما أن فيها الكثير عن محطات حياته: حيفا، عكا، صفد، القاهرة وعصر الثقافة الحقيقي فيها، الخرطوم، بيروت، وأخيراً عمّان.
أثارت «غربة الراعي»، التي صدرت طبعتها الأولى عام 1996، منذ صدورها، الكثير من النقاش، بحيث يمكن القول إنها من السِّير القليلة التي سجلت حضوراً لافتاً لمسنا آثاره بوضوح في غير ساحة ثقافية عربية، فتعدّدت طبعاتها.
لم يكن الاهتمام البالغ الذي قوبلت به سيرة الدكتور إحسان عباس مصادفة، لأن حضورَه المبدع في حياتنا الثقافية العربية كرَّسَه واحداً من قمم القرن العشرين القلائل على امتداد العالم العربي، وهو إلى ذلك أستاذ عدد من الأجيال التي تتلمذت على يديه مباشرة، أو على كتبه التي فاق عددها السبعين كتاباً، بين التأليف والتحقيق والترجمة.
يسجل للدكتور إحسان عباس تلك البصيرة النافذة التي جعلتْه منذ البداية مناصراً حقيقياً للتجديد في الأدب العربي، وخاصة الشعر الحديث.
ولذا، ليس غريباً أن يُكرِّمه العالم أيضاً وفي أكثر من مناسبة، كان آخرها قبل رحيله، 2003، حيث تمّ منْحه درجة الدكتوراه الفخرية من قبل جامعة شيكاغو، باعتباره واحداً من ألمع النقاد والمفكرين الذين تركوا بصمات عميقة في حياة شعوبهم الثقافية.
ومع حضور صاحب «غربة الراعي» الباهر من خلال إنجازاته، إلا أن هذه السيرة كانت مساحة واسعة لتأمّل حياة حافلة ممتدة على مدى ثلاثة أرباع القرن، وهو القرن الأكثر خطورة والأشد انعطافاً في حياة البشر على هذا الكوكب: كما يحلو للبعض وصْفه!
لكن «غربة الراعي» المرفوعة على يدي تاريخ صاحبها الثقافي كانت الحلقة التي لا بد منها لتأمّل التاريخ الإنساني الحميم، عبر شهادة حارة مؤثرة.
كتب إحسان عباس سيرته، غير معتمد على يوميات دوَّنها في أي مرحلة من مراحل حياته، وقدم في مطلعها إشارة تغمرها المرارة: «وإذا كان هناك من عيب في الإقدام على كتابة مثل هذه السيرة، فذلك هو أنها تأخرت في الزمن، وكان من الحقّ أن أكتبها قبل حلول الشيخوخة وامتلاء النفس بألوان الخيبة».
لكن المرارة والحزن والخيبة في النهاية ليست قيماً فنية، لأن القيمة الفنية تكمن في مستوى الكتابة ومدى صدقها. لقد جرت العادة أن تُحاكم سِيَر كتّابنا ومفكرينا في العالم العربي من خلال معيار الجرأة، وأُخذ على أصحاب السِّير باستمرار ذلك الخجل الذي يغمر صفحاتهم بفعل الظروف الاجتماعية والسياسية المحيطة بهم، وهو مأخذ لا يمكن إغفاله تماماً. كما أُخذ على أصحاب السِّير أنهم ملائكة دائماً ولم يقترف أي منهم خطأ في حياته، أو زلّة قدم بإرادته أو بغير إرادته، وأُخذ على بعضهم أنهم صوَّروا أنفسهم جوهر الكون! فإذا بهم أبطال ذلك الزمان وفرسانه دون منازع؛ وأُخذ على بعضهم الفردية الطاغية التي غيّبت التاريخ والبشر من حولهم، وكأنهم عاشوا في أماكن معزولة مثل حيّ بن يقظان، أو روبنسون كروزو، أو طرزان.
لكن مفهوم الجرأة مفهوم واسع، ومن الظلم استعارة النموذج الأوروبي للسيرة الذاتية في كتابة سيرة عربية، مع اختلاف الظروف والقيم ومفهوم الجرأة نفسه، رغم أننا نتمنى أن يصل الإنسان العربي إلى درجة يُعبِّر فيها عن كامل ما في قلبه وعقله وروحه.
إن الجرأة في معناها ليست الفضائحية في اعتقادنا، إنها القدرة على الدخول إلى أعماق النفس واعتصار كامل التجربة، بل وتقطيرها، لتقديم روحها الخالصة في أصدق صورة، وأيّاً كانت النتيجة. إنها ببساطة استعادة متأنية ووقفة مخلصة أمام تاريخ الروح بأكمله.
ولكن هل تستطيع سيرة ما أن تكون كاملة من جميع نواحيها؟ بالتأكيد: لا، لأنها ببساطة سيرة إنسان أولاً وأخيراً. ولذلك، نخشى أن تكون مطالبة بعضنا لكتّاب السِّير بقول كل شيء تعويضاً فقيراً عن عدم قدرتنا على البوح بأي شيء.
من هنا، ونحن نطالب كاتب السيرة أن يظل إنساناً، نبقى مُطالَبين بشكل أو بآخر أن نقرأ سيرته قراءة إنسانية غير متطلعة للعثور على البطل فيه!
ولكن، أين موقع سيرة إحسان عباس من هذا كله؟
تشكل «غربة الراعي» في جوهرها سيرة من نوع خاص، ولعل اختلافها كان السبب الأساس في الموقع الذي احتلتْه بين كتب السيرة العربية، وهي ككل كتابة من هذا النوع طالبها نقاد كتبوا عنها بالكثير، غير آخذين بعين الاعتبار وجهة نظر صاحب السيرة نفسه الذي أمضى عمره كله في خدمة الثقافة العربية، وكان هدفه الدائم تقديم كل ما لديه. من أجل تطلعات الإنسان العربي، لا من أجل فرح خاص يمكن أن يحسّ به وهو ينظر إلى صورته في الإطار.
إنها ببساطة صورة العالِم، وقد كنا نسمع ونقرأ عن أولئك المخلصين لعلمهم وللحقيقة، ونخالهم بشراً من غير هذه الأرض. لكن من يعرف إحسان عباس عن قرب، وأنا سعيد أنني عرفته جيداً لسنوات طوال، وشرّفني بالطلب مني قراءة سيرته قبل أن تنشر، والبحث عن عنوان لها، من يعرفه سيدرك المعنى العميق للتضحية من أجل العِلم ومن أجل الحقيقة.
سألني أستاذنا إحسان عباس يومها: («ولماذا «غربة الراعي» يا إبراهيم؟!») فأجبت: « لثلاثة أسباب: «لأنك بدأتَ حياتك راعياً لغنم أهلك طفلاً، وكابدت غربة الاقتلاع من وطنك»، فسألني عن السبب الثالث، فقلت: «لأنك رعيتنا جميعاً، ككتاب، ورعيت الكتابة العربية منذ مطلع الخمسينيات، وفي الوقت الذي كنت فيه وطناً جميلاً لأرواحنا وكلماتنا، كانت الغربة أبرز رفاق رحلتك»!
وبعد:
في مدينة ماسترخت الصغيرة الجميلة، كان عين الغزال، ذلك الشاب الفلسطيني، يستعيدك من تلك الغربة، ويقول بلساننا جميعاً: «نحن منك بقدر ما نحن من أوطاننا».