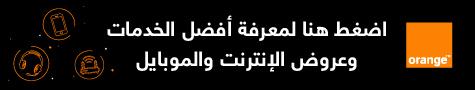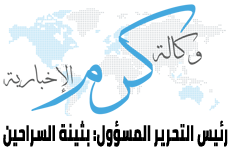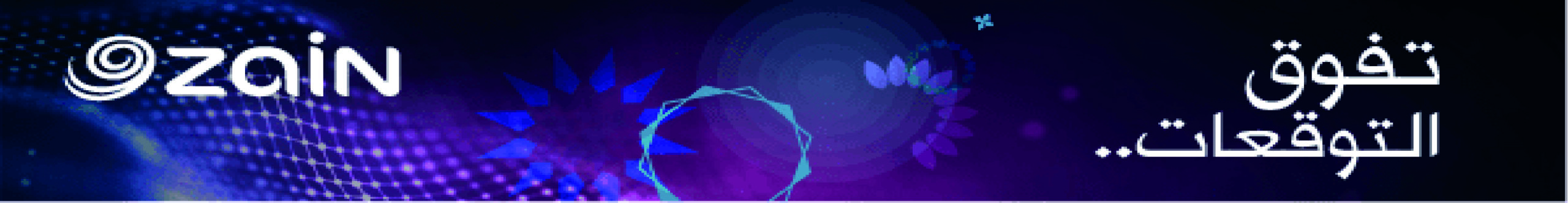إبراهيم جابر: في المخيم إمّا أن تصاب بالنقصان أو بالموهبة

حوار / رشا سلامة*
لعِبَ المخيم دوراً محورياً في حياة الأديب والصحفي، إبراهيم جابر إبراهيم؛ إذ كان مسقط رأسه مخيم عقبة جبر في أريحا، حيث استقرت عائلته بعد تهجيرها من قرية النعاني- قضاء الرملة، خلال نكبة 1948، ليختبروا التهجير مرة أخرى، وهو لمّا يزل يبلغ من العمر عاماً واحداً، حين ألمّت بهم نكسة ١٩67، فحطّوا رحالهم في مخيم الوحدات في الأردن
يقول إبراهيم جابر، الذي عمِلَ طويلاً في الصحافة الأردنية، لينتقل بعدها للصحافة الإماراتية: “في المخيم يجري اختبارك كلّ يوم داخل مصنع للصبر والأمراض والإيمان، وهناك تمكث فلسطين في الزاوية مثل إله يراقب ويُعلّم ويعاقب ويؤجل المكافأة لاحقاً”.
في حوار “حفريات” معه، يقول إبراهيم جابر إنّ ثمة استسهالاً يلحظه لدى من يقدّمون محاولاتهم الكتابية عبر منصات التواصل الاجتماعي، كما يشير إلى “من يجيد التسويق لنفسه أكثر بكثير ممّا يُسوّق لكتابته، ويصير اسمه أكثر ذيوعاً من أسماء نصوصه”.

حول أمور عدة، في الصحافة والكتابة والمخيم والمهرجانات الأدبية، كان هذا الحوار مع إبراهيم جابر إبراهيم:
اخترت الاغتراب منذ أعوام طوال، وكنت منخرطاً قبلها في العمل الصحفي في الأردن، وما تزال تطلّ عليه عبر مقالاتك؛ فما الذي ترى أنّه بقي على حاله في الوسط الصحفي الأردني، وما الذي تغيّر؟
ضمن سُنّة التغيير لا شيء يبقى على حاله، بالمعنى البدهي للجملة، ولا شيء أيضاً يخرج من حاله الأولى، فثمة روح لكلّ شيء، تبقى تمسك بالشكل، حتى وإن تغيَّر الشكل، والصحافة هناك هِيَ هِيَ؛ لأنها وليدة اعتبارات كثيرة، على رأسها شروط المجتمع القبلي.
اقرأ أيضاً: كيف يمكن “صناعة السعادة” مع وباء كورونا؟
تغيَّرت أشكال العمل الصحفي، وحلَّ اللابتوب مكان ورق المطبعة الأصفر الذي كنت أحبّه كثيراً، وأحمل منه كميات معي أينما ذهبت، وحلَّ صحفيون شباب مكاننا، لكن ماهيّة الصحافة لم تتغير والسقوف على حالها، بل أظنّها انخفضت.
هناك صحافة غير تقليدية تتمثل بالمواقع الإلكترونية، لكنّه بسبب قِصَر عمر الأشياء والأجيال الآن، صارت صحافة التواصل الاجتماعي المائعة تنافس كليهما (الصحف والمواقع)، ولم تعد هناك مكانة مهابة للصحافة كما الماضي.
لك آراء منشورة حول وسائل التواصل الاجتماعي، معظمها ينتقد ما يمكن الاصطلاح عليه “الاستسهال والفوضى” في هذا الفضاء؛ هل بقيت رؤيتك ذاتها لهذه الوسائل، وتحديداً فيما يتعلق بالجانب الأدبي والثقافي؟
رؤيتي الناقدة ليست لوسائل التواصل بذاتها، فهي أدوات غنيّة ومطيعة، لكنّ الاستخدام العشوائي، بل المسعور أحياناً، هو ما شوّه هذه الوسائل.
يمكن القول إنّ ما حدث لها، في محيطنا العربي، يشبه أن تأخذي مجموعة من سكّان الغابات إلى “ديزني لاند”!
المخيم كل تلك التفاصيل التي لا يُمكن عدُّها. في المخيم سقينا الفولاذ، وصنعنا منه شتلات خضراء وكنزات من الصوف
“الاستعمال”، هذه المفردة الخطيرة هي التي تصنع النتائج دائماً، ونحن كعالم ثالث لدينا خبرات (عظيمة) في سوء استعمال الأشياء.
والاستسهال الذي حدث في مجالات الإبداع ناجم عن بحث محموم عن الشعبية والرواج، فالجمهور الكسول الذي يراقب حصول المبدعين على نجومية كبيرة على وسائل التواصل لم يقنعه دور “الجمهور”، وهذه نظرية راسخة في العالم العربي؛ حيث غالبية الجالسين في أيّ أمسية أو محاضرة دائماً ما يشغل تفكيرهم سؤال واحد: لماذا هو على المنصة وأنا على مقاعد الحضور؟ّ! لذلك جرى استسهال الكتابة والرسم والغناء، والسطو على صناعة الإبداع، بحثاً عن النجومية، ولم يعد هناك وجود للمتلقي.
اقرأ أيضاً: رواية “حصن الزيدي”: عودة الإمامة برداء جمهوري!
والمفارقة أنّ هذا الرأي يستفز الناس، ويدفعهم دائماً للقول: ولماذا تريدون احتكار الكتابة؟ وأنا أسأل: لماذا كلّ مهنة لها شروطها التي يجري احترامها إلا الابداع؟ ألا يدافع الأطباء عن مهنتهم ببسالة وكذا الصيّادون عن شواطئهم، والنجّارون، وحتى تجّار المخدرات والقَتَلة المأجورون، فلماذا وحدهم “الكُتّاب” إن دافعوا عن مساحتهم اتهموا بالاحتكار؟ الكتابة صنعة عظيمة ومحترفة، وليست مجرد تهويمات وخواطر لملء وقت الفراغ، هذه هي الفوضى التي أنتقدها، لا وجود وسائل التواصل، أقصد “الاستعمال”.

تكتب النصّ الصحفي بأنواعه، والأدبي شعراً ونثراً؛ أيّ الضروب الكتابية يجدها إبراهيم جابر أقرب له؟ وكيف يختار القالب الذي سيقدم فكرته من خلاله؟
ما يحدث هو أنني أجد الفكرة، أو للدقّة تداهمني الفكرة، فأضعها في الجنس الأدبي الملائم لها، والفكرة الصارمة والواضحة هي التي تُحدّد غالباً أين تضعُ نفسها.
أنا لستُ معنيّاً كثيراً ولا يؤرقني أين سيضع النقاد كتاباتي، وعلى أي رفّ؛ همّي دائماً أن أكتب ما يشغلني، وأثناء ذلك تشغلني دائماً لغتي الخاصة.
اقرأ أيضاً: أي مستقبل لتجربة المسرح الصحراوي عند العرب؟
وحتّى في الصحافة، ومنذ بدأت العمل والكتابة فيها، قبل ثلاثين عاماً، لم أكتب باللغة الصحفية المعتادة والسهلة والرائجة، فكانت مقالتي غالباً قريبة من نصّي الأدبي، وهذا ليس شأناً يخصّني، حيث دائماً ما شكَّل معضلة للأدباء الذين عملوا في الصحافة، فالصحافة تسرق لغتهم وأفكارهم في مقالات ستبلى مع ورق الجرائد آخر النهار مضيّعين فكرة وجهداً وشغلاً كان يمكن أن ينتج قصة أو قصيدة، لكنَّ الأمر يحدث هكذا، فـ “الكاتب” لا يمكنه سوى أن يكون كاتباً في كلّ شأنٍ يفعله.
أما بخصوص أيّها أقرب لي؛ فهو الشعر حتماً، والشعر حيث وُجد، فربما كان محشوراً أحياناً بين سطرين في مقالة.
ارتبطتَ بالقضية الفلسطينية وجدانياً لعقود طويلة، وكان للمخيم الفلسطيني أثره الكبير في هذا الوجدان والرؤية السياسية؛ هل ما يزال إبراهيم جابر طفل النعاني اللاجئ في مخيم الوحدات؟ هل ابتعدت فلسطين أكثر من السابق؟
هذا ليس خَياراً؛ فأنا مصنوعٌ من فكرة المخيم، ذلك الجحيم العالي الشأن الذي أدينُ له بكلّ أمراضي وتشوّهاتي ومواهبي، لا شيء في حياتي أبلغ منه، ولا علاقة لذلك بهوية وطنية أبداً، بل بمختبر إنساني فذّ.
المخيم كل تلك التفاصيل التي لا يُمكن عدُّها، والتي يمكن لوصفها وتكثيفها أن أستعين بعنوان رواية جاك لندن “حين سقينا الفولاذ”؛ في المخيم نحن فعلاً سقينا الفولاذ، وصنعنا منه شتلات خضراء وكنزات من الصوف وبطاقات بريدية.
اقرأ أيضاً: التشكيلي السوري لؤي كيالي: الرائي الذي اختطفته النيران
لا يمكن لأحد أن يصف المخيم لأحد لم يعش فيه، لا علاقة للأمر بشكل مباشر بثنائية الوطن والمنفى، أو بالبلاغة في الوصف، أبداً…هناك يجري اختبارك كلّ يوم داخل مصنع للصبر والأمراض والإيمان.
وهناك تمكث فلسطين في الزاوية مثل إله يراقب ويُعلّم ويعاقب ويؤجل المكافأة لاحقاً،
لم يخرج أحدٌ من المخيّم سالماً: فإمّا أن تصاب بالنقصان أو تصاب بالموهبة !
فلسطين لم تبتعد في يوم كما هي بعيدة الآن، لكنها لم تكن في يوم قريبة، فالذي كان يجعلها قريبة هو نحن، أقصد إيماننا بأدواتنا وبمشروعنا، المشروع تمّ إفراغه من مضمونه وتعطيله بدعاوى سياسية لا داعي للخوض فيها هنا.
اقرأ أيضاً: النميمة بين الأدباء في المقاهي: ما الخيط الفاصل بين التسلية والأذى؟
على الصعيد الشخصي، أنا لم أعد أنتظر شيئاً، درَّبتُ نفسي على الخسارة، وبخصوص من سيأتي بعدنا أؤمن جداً بالناس، الناس الذين سينهضون يوماً ما، ربما غداً، وربما بعد سبعين عاماً، الناس الذين حين أراد الله أن ينسب نفسه لأحد قال: {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (1) مَلِكِ النَّاسِ (2) إِلَهِ النَّاسِ}.
تزدهر مهرجانات الجوائز الأدبية بقوة في الدول العربية، وتلقى من الاستحسان والانتقاد أيضاً ما تلقاه، يبدو أنّ إبراهيم جابر خارج هذا السباق ولا ينخرط فيه؛ هلّا حدثتني عن رؤيتك لهذه الجوائز؟
في الحياة الإبداعية عموماً، ومثل أيّ منتَج أو صناعة، هناك حصّة كبيرة ومهمة لـ “التسويق”، وهناك من يجيد التسويق لنفسه أكثر بكثير ممّا يُسوّق لكتابته، ويصير اسمه أكثر ذيوعاً من أسماء نصوصه.
انا أكتب نصوصي وقصائدي، وأتركها تمشي في الحياة، وحدها، بلا رفقتي، ودون إعلانات.
ذَكَرَ محمود درويش ذات مرة أنّ أجمل نتاجه، بالنسبة إليه، ما كتبه في باريس، لا ما كتبه تحت القصف والحرب، بعكس ما كان يتوقع القارئ؛ أين يرى إبراهيم جابر المكان الجغرافي الأفضل، عموماً، للكتابة؟
هذا دقيق جداً نقدياً، حتى إنّ محمود درويش لم يضع “مديح الظلّ العالي” لاحقاً في أيّ ديوان، ولم يتعامل معها كشعر، رغم شعبيتها الجارفة، وانفعال المتلقي بها.
فالكتابة التي تحدث في أسر شروط عاطفية هي كتابة انفعالية، ورغم أنني أفضّل أن ننسب الكتابة للزمان وليس للمكان، بمعنى عمر التجربة ووعيها لا مكانها، إلا أنني أتفق تماماً مع الفكرة، فأية “صناعة” محترفة تحتاج إلى الأمان والاسترخاء؛ لذلك فالمكان الأفضل للكتابة هو الوحدة
والهدوء البالغ والمكان غير المشروط.
صباحُ الخير يا “مخيم الوحدات ”
الآباء ينهضون من النوم للتوّ
ثم يعودون للموت ثانية .
شجرةٌ صغيرةٌ تُحدّق في الشمس الصغيرة: لَم أفهم المنفى!
فتى يقول لصاحبه: “لا تحزن !”
سنكبرُ
في “وسط العاصمة” الملوّن
وسنقع في الحبّ مثل الكبار .
..
خرج الناسُ من ألبوم الصور القديمة :
لا شاي على الشبّاك ولا أمّ تغرفُ من عبّها الأشواق
لا يمرّ الفدائيون بعد العاشرة ليلاً .
لا يكتبُ العشّاقُ شِعراً كما يكتبُ العُشّاق .
..
الشتاء يُغرق “مدارس الوكالة”
والأم تطبخ الحصى والأب يشرحُ لطفله سورة “الرحمن”
صوتُ الرعدِ يشلعُ سقف البيت وقلبَ الابنة الصغرى.
..
والطفلُ يسأل: لم لا نرحلُ؟!
يجيبُ الأب: يحدثُ هذا لأنّا رَحـلنا .
*نقلا عن حفريات