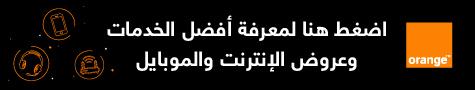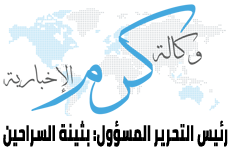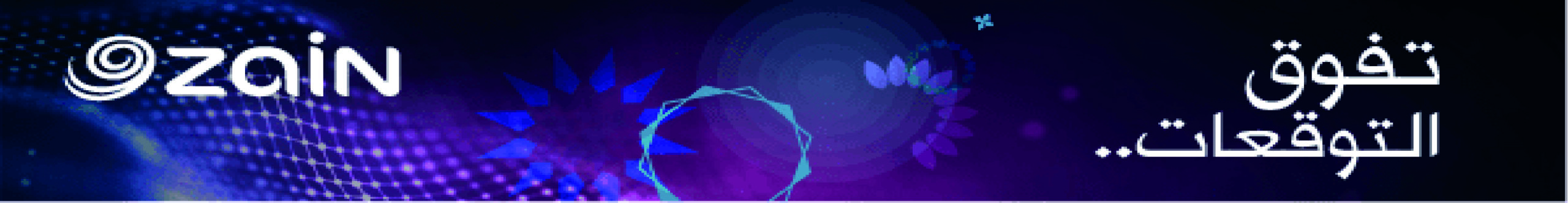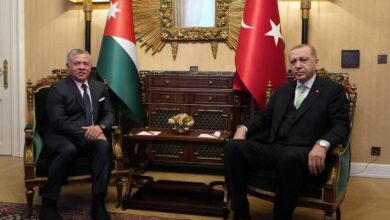أحمد منصور محترقاً

موسى برهومة
تكثف صورة الصحافي الفلسطيني المحترق أحمد منصور، في خيمة للصحافيين في قطاع غزة، الأسبوع الماضي، مأساة تتعدى حرق الأجساد إلى حرق الروح، وتحطيم القواعد الأخلاقية، وخروج الإنسان من ثوب كينونته وانبثاقه وصيرورته وفنائه.
الفيديو (لمن شاهده) يجمّد المشاعر، كأنما إشارة صدرت من أصبع ضاغط على زرّ شاء أن يوقف المشهد، لا ليتفرسه، وإنما لكي ينعى من خلاله آخر ما تبقى من أنفاس الرحمة. لقد ماتت الخيرية يا “كانط”، وصار الكائن/ الآلة هو من يقرر مصائر البشر في هذا الكون الأعشى الذي أضحى، بسبب لعنة الحضارة، أعمى في بصره وبصيرته.
كانت السينما أسبق إلى تصور المآلات التي تنتظر البشر، فقد ركز الخيال العلمي، منذ زمن بعيد، على إنتاج كائنات آلية مصممة للفتك والتدمير، ومبرمجة من أجل إذلال فكرة الإحساس والتعاطف. كان ذلك في زمن الخيال الذي يهدف إلى الإمتاع والتشويق وبث إثارة ما (ربما بريئة) في عروق الكائن المتسمّر أمام الشاشة. فالتعلق بأفلام العنف والرعب، التي تجد استحساناً لدى غالبية مشاهدي السينما، آت من الكبت النفسي الهاجع في اللاوعي الذي لم يتخلص الإنسان منه، فوجد ضالته في الأفلام أو في الفن، أو في العنف المادي الذي تختلط فيه مشاعر العدوان بالكراهية، وقد أفاض “فرويد” في تشريح ذلك، حيث عزا العنف إلى عدم إشباع دوافع اللذة “الليبدو” المركبة من الرغبات والمشاعر والانفعالات والنزوات والميول، التي تتصارع بشكل مفتوح مع غريزة الموت.
لم تكن تلك الأفلام تبشر أو تدعو أو تحث على الإبادة المبرمة للجنس البشري، لكنها الآن، في غزة، وفي سواها من الساحات المنكوبة بـ”تسونامي الشر”، تصبح هدفاً ومراداً. القاتل تعلّم من المخرج ومن كاتب السيناريو، فراقَ له العمل، وأراد أن ينفذه بحذافيره، وعلى الهواء مباشرة، وبلا عدة إنتاج، أو ميزانية، أو ممثلين، أو خدع فنية، أو مؤثرات بصرية، أو استعانة بمؤهلات الذكاء الاصطناعي. صار القاتل ملهِماً للكاتب، ومفجراً في خيال المخرج ما لم يخطر في بال بشر.
في فيلم تيتان (Titane) للمخرجة الفرنسية جوليا دوكورناو، الحائز على السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي، 2021، نعثر على إنسان شبه آلي تتحول برمجته الوجدانية بعد زرع لوحة من معدن “التيتانيوم” في جمجمة بطلة الفيلم ألكسيا (الممثلة المدهشة أغاثا روسيل)، في أعقاب حادث سيارة في طفولتها.
اللوحة المزروعة في الجمجمة أعلى الأذن اليمنى تتصل بالأوامر العقلية التي تجعل المفاهيم الأخلاقية منزوعة من سياقاتها المنطقية، حيث العنف يغدو غاية ووجهة ومتعة. فالقتل المتسلسل بدم بارد وبمقدارعال من التوحش وعدم تأنيب الضمير، يصبح هو القاعدة. أما الحنان والتعاطف أو الحاجة إليهما، كما تبدو في لحظات النصف الثاني من الفيلم، فتبدو كأنها استثناء.
ألكسيا، التي تهرب من الشرطة بعد جرائمها، تُجري تغييرات في مظهرها حتى لتبدو مثل شاب يعثر عليه ضابط في فرقة الإطفاء فيقنع (أو يوهم) نفسه بأنه ابنه المفقود منذ عشر سنوات “أدريان”.
ولإنجاح هذه الخدعة تمارس ألكسيا على نفسها عنفاً منقطع التخيل، إذ تحلق شعرها وحواجبها، وتكسر أنفها بشكل متوحش يهزأ بالألم، ثم في مرحلة لاحقة تحاول بقر بطنها بمخرز الشعر الطويل لتخفي حملها بعد أن تكون قد مارست الجنس مع سيارة (!!)، فيكون دم الجنين أسودَ مثل زيت الحافلات المحروق، في رؤية هيتشكوكية معجونة بأنفاس كافكا الكابوسية، وتصورات شوبنهاور العدمية التي ترى أن الوجود هو بؤرة الحزن والكآبة والشر المطلق.
وعلى الرغم من كل هذا العنف الذي يكون واحداً من تعبيراته إحراق ألكسيا منزل العائلة بوجود أبيها وأمها، بعدما أغلقت عليهما الباب، إلا أنّ طيفاً من وعي المشاعر يتسرب إلى عروقها المعدنية في علاقتها بأبيها المفترَض الذي أقسم على حمايتها مهما كلفه الأمر، فإذ بنا أمام قلب يخفق، ودمع يترقرق في المحاجر، ويدين ترتعشان، وشفتين ممتلئتين بامتنان مخنوق.
كان ذلك في السينما، حيث الدم سائل أحمر يتفجر من الأجساد، وحيث العظام المنصهرة في أتون النار هو كومة من الخدع البصرية المصممة بالكمبيوتر. بيْد أن ما جرى في خيمة الصحافي أحمد منصور في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، كان حقيقة وثقتها الكاميرا لجسد لا يقوى على أن ينتزع كتلته، ويفر من اللهيب المحتدم الذي كبّل إرادة الناس الذين لم يتمكنوا من إنقاذ أحمد، وكان أقصى ما قدموه له، لضعف حيلتهم، هو رش قليل من الماء لإطفاء جهنم التي ذاب فيها الجسد الذي تفحم.
لم تكن مزروعة في أجساد القتلة شرائح “التيتانيوم”، ولم تجر إعادة إنتاج داخل المختبر لبرمجة مشاعرهم أو إعادتهم إلى فطرتهم الأولى قبل أن تلوثها وتعطبها أيديولوجيا المزاعم التوراتية وأكاذيبها وأوهامها. فقد سبق الذين ألقوا القنبلة الجهنمية على خيمة الصحافيين، ضابط إسرائيلي وعد طفلته أن يهديها، بمناسبة عيد ميلادها، تفجيراً لأحد المباني السكنية في قطاع غزة. ويقول الضابط في مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام، في السادس والعشرين من تشرين الثاني (نوفمبر) 2023: “أهدي ابنتي بمناسبة عيد ميلادها الثاني، هذا التفجير، إني اشتاق لها”!
الواقع، الآن، يسدد لكمة منكرة للسينما، ويتجاوزها في مقدار الرعب المختلط بالشر الفتاك الذي تحترق فيه أجساد الأطفال، وتحترق معها صيحاتهم واستغاثاتهم، من أجل أم تبتهج وتحتفل طفلة لا تبعد كثيراً عنهم في الجغرافيا، ولا تختلف عنهم في الطينة البشرية التي جُبل منها الإنسان، لكنّ أقدار التاريخ اختلفت فأضرمت الحرائق في الجغرافيا ومن فيها ومن عليها. ولم تقف عند هذا الحد، فقد طاول الحريق الشرائع والأديان والنواميس. وإذ تنجز النار هذه “المهمة” الآثمة، فإنها تحرق آخر ضلع في نعش الخير والرحمة.