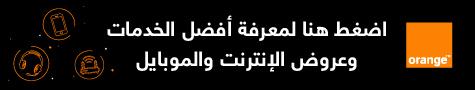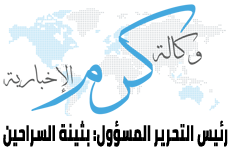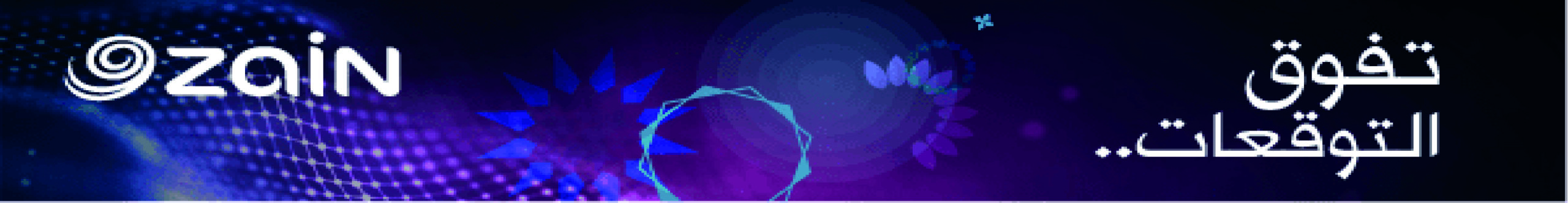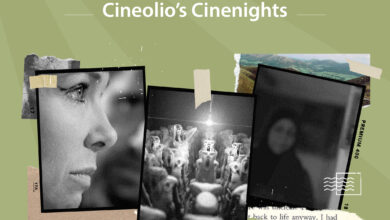محمود درويش: الشجرة الأعلى في غابة الصنوبر المعمرة
“.. وعصافير بلا أجنحة خُلقتْ لتطير وتحلِّق.. وتدوِّخ اللحظات في تحليقها.. شاء لها القدر أن تقصَّ أجنحتها.. وتنزف دمها على شوك الألم والحرمان…
عصافير خُلقت لتغنّي على الينابيع الزرقاء.. وفي الآفاق الزرقاء.. شاء لها القدر أن تضيع.. وتتحرَّق بلا سماء.. وبدون أرض..
وراء أسلاك الصمت والضياع.
لهذه العصافير أغني.. وأتألم.. وأثور…!”
هذا ما كتبه محمود درويش (13/3/1941 ـ 9/8/2008) في مقدمة ديوانه الشعري الأول “عصافير بلا أجنحة” (1960)، وكان في التاسعة عشرة من عمره يعيش مع أهله في فلسطين المحتلة، في قرية زراعيّة أقامتها إسرائيل على أنقاض قريته “البروة” التي دمَّرتها.
وكنّا آنذاك، في لبنان، ننتظر صدور دواوين ذاك الشاب الذي كانت تعتقله السلطات الإسرائيليّة بسبب تصريحاته الثوريّة ونشاطه السياسي، ننتظرها بلهفة تعادل لهفتنا لزيارة فلسطين القريبة من مدينتنا صيدا والتي لنا فيها أهلٌ وأحبّة.
أسرعُ لشراء تلك الدواوين الصغيرة الحجم، المكتوب، على الصفحة الثانية من غلافها، سعرُها 150 ق. ل (قرش لبناني). أغلّفها بورق النايلون الشفّاف لأحفظها، فلا يُبلي كثرةُ تصفّحنا لها ورقَها. كانت تلك الدواوين، بالنسبة لي، أشبه بالهدايا الثمينة التي كانت تحملها لي نهاد ابنة عمّ أمي من القدس، كلّما جاءت برفقة زوجها لزيارتنا في صيدا قبل العام 1946، أو أشبه بتلك الأيقونات الثمينة التي كانت تهديني إيّاها صديقتي ماري في مدرسة راهبات القديس يوسف للظهور في بيروت.
كان محمود درويش الشاعر/ المقاوم صورةً تعادل، في لا وعينا، صورة فلسطين. فلسطين البرتقال والزيتون وأهلها الذين حُرمنا من زياراتهم لنا.
هكذا ويوم أخبرني الصديق محمد دكروب بأنَّ محمود درويش قدِم إلى لبنان (كان ذلك عام 1973) وأنَّ الرفاق يفكرون بدعوته إلى لقاء في بيت من بيوتنا، بادرتُ إلى القول: عندنا، في بيتنا الصيفي في صبّاح.
على شرفة ذاك البيت المحاط بأحراش الصنوبر المعمّرة، في قرية صبّاح الواقعة شرق مدينة صيدا، على ارتفاع 900 متر عن سطح البحر، تحلَّقنا حول الشاعر، وكأنّنا نتحلَّق حول فلسطين ونستعيدها. أذكر من الحضور: كريم مروة، مهدي عامل، محمد دكروب، أنطوان عبدو، سليم عبود… إضافة إلى زوجي وأولادي: مازن وحازم وليلى.
أصرّت ليلى (سبع سنوات) التي كانت تحب شعر محمود درويش وتعتزّ بحفظها لبعض قصائده، أن تستقبله بإلقاء بعض الأبيات من ديوانه “الخروج من البحر المتوسط”. هكذا، وبتشجيع من الشاعر، راحت تنشد ما تحفظه كمنْ يقف على خشبة مسرح: “سيل من الأشجار في صدري/ أتيتُ/ أتيتُ/ سيروا في شوارع ساعدي تصلوا…”.
في بيروت، وفي بعض المناسبات الثقافيّة، كنت ألتقي محمود درويش، وكان يسلم عليّ بألفة كأنّه يشجعني، أنا الأنثى/الأم، الخجولة، التي ما زالت في بداية طريقها ككاتبة. أتذكّر تلك الندوة التي دعا إليها اتحادُ الكتّاب اللبنانيّين حول موضوعة النقد، وشاركتُ فيها مع الياس خوري، وكنّا، يوم ذاك، عضويْن من أعضاء مكتب الاتحاد المنتخَب.
اختلفتُ، فيما قدمتُ يومها، مع الياس خوري الذي اعتبر النقد تأويلاً، بينما أكَّدتُ على هذه العلاقة بين الأدبي والمرجعي الحيّ. وجادلني الياس معتبراً ما يقوله هو الصواب، فما كان من محمود درويش، الذي لاحظ انزعاجي من أسلوب خوري في النقاش، إلاّ أن بادر يقول لي: لا تردّي عليه، تابعي ما تبحثين عنه. يقصد هذه العلاقة بين الأدبي والمرجعي.
أتذكر وأتساءل اليوم: هل كان محمود درويش، بمساندته لي، يجد صدًى للفكر المادي/الماركسي الذي كان ينتمي إليه! وهل اطلع على ما كنتُ أكتبه في مجلة الجديد بناءً على طلب محرِّر ملحقها الثقافي سلمان الناطور الذي التقيته في ندوة في أثينا؟ لم أكن أدري يومها أن محمود درويش كان، بعد إنهائه دراسة المرحلة الثانوية، هو المشرف على الجديد.
أستعيد اليوم ذلك الزمن، وأدرك معنى مساندة محمود درويش لي، هو الشاعر المقاوم، الذي طرح عليه سؤال الشعريّة باعتبار العلاقة بين الشعر والواقع، الواقع الذي عاشه محمود درويش بصفته مواطناً فلسطينيّاً حرِم من وطنه، ومن قريته التي ولد فيها، ومن بيته الذي تنشَّق فيه رائحة خبز أمه. عن هذه العلاقة بين الشعري والواقع المعيش كان يدافع محمود درويش حين دافع عني، هو المناضل اليساري الذي انتمى، مذ كان تلميذاً، إلى الفكر المادي والقيم الإنسانيّة، إضافة إلى نشاطه السياسي ومواقفه المعلنة ضدَّ ظلم السلطة الإسرائيليّة، وتدميرها بيوت الفلسطينيين، وتهجيرهم. هجّرتهم وهجّرته معهم ليعود، كما يقول، راكباً: “مفردة واحدة. هي الوطن”.
يعبّر محمود درويش عن هذه العلاقة بصفتها معاناة شعريّة تدعوه إلى التخلّص من مهارات اللغة. أتذكّر ما كان يقول في هذا الصّدد: “يا إلهي! أين إنسانيّتي/ يا إلهي! كيف أنجو من مهارات اللغة/ كل شيء قابل للاحتراق/ في احتمالات الكتابة”؛ ثم يصرِّح: “ما قيمة الشعر إذا لم يتحوَّل إلى قوة. القوة لا تأتي من الشعر ذاته، بل هي من علاقة التفاعل بين الشعر والناس” (مجلة صباح الخير العدد 36، تاريخ 12/4/1976).
عام 1979 وإثر لقاء له مع جماهير من الشعب العربي سمعتُه يقول: إنَّ العقبة ليست بين الشعر والناس. إنها عقدة أشباه المثقفين، ثم يضيف، معبراً عن تأثره بما لمسه من تفاعل الناس بشعره: هذه المرة بكيت، وولدت من جديد.
من أجل هذه العلاقة، علاقة التفاعل بين الشعر والناس، كنت أركّز في بحثي النقدي للأدب على العلاقة بين المرجعي الذي هو ما يعيشه الناس وينسجونه، وبين المتخيّل الأدبي. هذه العلاقة الموسومة بحب الحياة، الحياة التي هي حقٌّ لنا، والتي نناضل كي تبقى لنا.
كانت الصدف المنطوية على الجذر الثقافي المشترك هي التي تجمعني بالشاعر محمود درويش، ألتقيه وتبقى هالة التقدير له ولما يمثّله تلفّني وتوقظ، اليوم، ذاكرتي بأكثر من مناسبة ثقافيّة كنتُ التقيه فيها.
أذكر يوم طلب مني أن أكتب لمجلة “الكرمل” الفلسطينيّة التي أسَّسها في بيروت عام 1981، وعمل رئيساً لتحريرها حتى وفاته. كانت “الكرمل” منبراً للإبداع الفكري والأدبي، حملتْ أسئلة الثقافة العربيّة المعاصرة، وانخرطت في قضيّة التحديث وعانت، شأن الفلسطينيين، الهجرة والتنقل: من العاصمة اللبنانيّة بيروت، إلى العاصمة القبرصيّة نيقوسيا، إلى رام الله في فلسطين. إنه “زمن الطغاة”، حسب تعبير درويش، الذي امتدَّ وطال، وكانت معاناة الشاعر منه تتمثل في فيضه الشعري، في قوله: “ليس لي وجه على هذا الفراق/ الشظايا جسدي/ والمسافات عناق/ آه لو يبتعد الموتى عن الموت قليلا/ لأراهم في تفاصيل الأمل”.
خرج محمود درويش من بيروت مع الخروج الفلسطيني (أيلول/سبتمبر 1982) تاركاً صدى حضوره النابض بالحياة على منابرها وفي أكثر من كتاب، منها “ذاكرة للنسيان” الذي قرأته مراراً، والذي كنت كلّما قرأته أتنشق رائحة القهوة التي يعشقها، وأتذكر هدير الطائرات الإسرائيليّة التي كانت تمطرنا بقذائفها.
خرج الشاعر من بيروت، بل رحل تاركاً لنا شعراً أسمعه بصوته يقول: “وأرحل عن شوارعها/ وأقول ناري لا تموت/ وعلى البنايات الحمام/ على بقاياها السلام/ شكراً لبيروت الضباب/ شكراً لبيروت الخراب”. بعد الخروج الفلسطيني من بيروت التقيت محمود درويش عام 1985 في مدينة مكناس في المغرب، البلد الذي له عندي أكثر من ذكرى. مكناس الاسم الأمازيغي، وجامع الزيتونة، والسلطان مولاي إسماعيل الذي أمر ببناء هذه المدينة لتصبح العاصمة الجديدة لمملكته.
تحضرني الآن صورة وقوفي إلى جانب الروائيّة الفلسطينيّة الصديقة ليانة بدر، وقبالتنا الشاعر محمود درويش. لما زلت أسمع صوته يقول لي مشجِّعاً: “يلّلا وقّعي”. كان بعض الطلاّب والطالبات المغاربة يحملون نسخاً من كتابي “في معرفة النص” الصادر وقتها في المغرب. أسمع صوته الآن وأستعيد صورته على المسرح، مثل إله أسطوري قادم من أعماق الزمن الفلسطيني، يلقي شعره بصوت تُرجِع القاعةُ صداه، وتضجُّ بالتصفيق…
تكرّرت لقاءاتي بمحمود درويش بعد خروجه من بيروت، وذلك في إطار مشروع ” كتاب في جريدة” الذي كان يصدر بالتعاون مع وزارة الثقافة والتعليم العالي في بيروت، ويتولّاه الشاعر العراقي شوقي عبد الأمير. كنت إلى جانب عدد من الأدباء والشعراء العرب عضواً في اللجنة المنوط بها اختيار كتاب (شعر أو رواية) لينشر في شكل جريدة ويوزّع مجانا. كنّا نجتمع في بيروت، أو في القاهرة، أو في باريس. سألتُه مرة عن رأيه في رواية عربيّة كان بيعُها قد سجّل رقماً قياسيّاً، قال: “قرأتها ولكن لا أشعر برغبة في قراءتها مرة ثانية”. بعدها اقترح رواية “الضوء الأزرق” لحسين البرغوثي بصفتها جديرة بأن تُنشر في “كتاب في جريدة”. أوجز رأيه فيها، وترك للجنة القرار.
أتذكره في لقاء لم أكن أتوقع أنه سيكون الأخير، كان ذلك في فرنكفورت بمناسبة معرض الكتاب الذي كان العالم العربي ضيف الشرف فيه (تشرين الأول/أكتوبر 2004)، وكان لدرويش “قراءات شعرية” بمصاحبة الفنانيْن الفلسطينييْن: سمير ووسام جبران. في اليوم ما قبل الأخير صادفته جالسا بمفرده إلى جانب جدار الممشى العريض الذي يعبره الخارجون من قاعة الاحتفالات، وكأنّه ينتظر خروج أحدٍ ما؟ ما زال صوته يرنّ في أذني: “كيفك يا دكتورة”. استغربت حينها “يا دكتورة”، وأتساءل اليوم: هل كان ما زال عاتباً، كما أخبرني الصديق كريم مروه. “لم تتصل يمنى لتسأل عني”. قال له، وكان ذلك يوم أجرى عملية القلب المفتوح في باريس وكنتُ وقتها فيها. كان ذلك بسبب خجلي من المبادرة للكلام مع شاعر هو أسطورة فلسطين الذي لا أملك لغة أخاطبه بها.
يوم وصلني خبر وفاته، كنت أقف على شرفة بيتنا الصيفي، بكيت، وعبر دموعي رأيته… كان هناك يتربع فوق أعلى شجرة من أشجار غابة الصنوبر المعمِّرة.